المستقبل لا نراه إلا في الأفلام
يا ترى كيف سيكون شكل الحياة والمستقبل بعد عدة عقود أو نصف قرن من الآن؟ ما هي استعدادات البشرية للزمن المستقبلي؟ وكيف سيتكدّس كل أولئك البشر على سطح الكوكب الأرضي بما يفوق طاقته الاستيعابية؟ وهل سوف تشحّ الموارد بما لا تكفي لكثرة البشر.
ببساطة إن العالم سوف ينقسم الأثرياء سوف يؤسسون مستوطنات في المجرّة القريبة والفقراء سوف يتركون ليواجهوا قدرهم.
خذ صورة أخرى لفساد العالم بالأوبئة والأمراض، قصة كوفيد – 19 والسارس بأنواعه سبق وأن جسدتها السينما وأرتنا أفلاما مثل فيلم “مرض معد” أو الشهير بـ”كونتاغيون” 2011، الذي تنبأ بما يشبه كوفيد – 19، ثم “فايروس سولانيوم” 2013، وقبل ذلك فيلم “الفايروس وتقاطع كاسندرا” 1976 وغيرها من الأفلام.
على أن الشاشات ذهبت بعيدا في نقلنا إلى المستقبل إلى درجة أنها تجاوزت ثورة الأخ الأكبر إلى مجتمع توتاليتاري مدهش وشديد الغرابة، في فيلم لا أحد مثلا سوف تتم برمجة المجتمعات بأكملها بزرع خلية في جسم أو رقبة كل إنسان هي بمثابة مستودع للتعريف به إلى درجة أنك عندما تصادف شخصا في الطريق فسرعان ما تظهر على زجاجة النظارة الخاصة التي ترتديها معلومات عن ذلك الشخص، وعندما تختلط مع حشد من الناس سوف تتوالى المعلومات الصادرة من الملف الرقمي المزروع في كل منهم.
بالطبع يكون ذلك بعدما تفنى أعداد هائلة من البشر وهكذا يكون هنالك دائما مجتمع الناجين وكيف يسيّرون حياتهم في مجتمع يشبه مجتمع الأخ الأكبر في رواية أورويل 1984.
وما بين الديستوبيا والناجين سوف يتم بناء تلك الدراما الأرضية الغرائبية التي يكون فيها المجتمع قد تم تطهيره كليا من الشوائب البشرية من العناصر المؤذية والفاشلة والطفيلية.
ولنعد خلال ذلك إلى صورة المستقبل التي لا تعنينا كثيرا وكأننا خالدون أو أن الأجيال القادمة لا وجود لها، فسؤال المستقبل الذي تقدّمه الشاشات يحمل صدمة في بعض الأحيان على الرغم من غرائبيته، صورة وسؤال المستقبل يتكاملان في مجتمعات الغد على الشاشات ومن ذلك تلك المدينة الافتراضية الفاضلة في أفلام مثل فيلم “أوبليفيون” وفيلم “حافة الغد” وفيلم “المعطي”، وفيلم “إيليسيوم” وغيرها.
وهنا سوف يتم بناء نظام شامل للحياة يحمل ميزات الاختلاف البشري والتلاعب بالجينات الوراثية والسيطرة على الدماغ البشري، ومن الطريف مثلا في فيلم “المعطي” أن البشر لا يعودون يعرفون معنى المشاعر الإنسانية كالحب والشوق والعشق بل إنهم لا يحزنون ولا يتأثرون بدعوى أن تلك المشاعر تستهلك الكائن البشري وتمنعه من الإبداع في مجالات أخرى فضلا عن كونها تستسنفد وقته.
والحاصل أننا بصدد أن نشكر السينما التي ربما تكون هي المرآة الفريدة للمستقبل الذي لطالما نستبعده تحت شعار غدا بعلم الغيب واليوم لي بينما تلك الأفلام تزجنا في عمق الغد وتتركنا مذهولين حتى ندرك أن المستقبل كامن في الحاضر ولكن من دون أن نراه أو نعطي له أهمية حتى تذكّرنا الشاشات به فنزداد دهشة واغترابا.
نبذه حول الكاتب
اديب عراقي وصحفي، يكتب القصة القصيرة والرواية
تقييم النص
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد ! كن أول المعلقين !
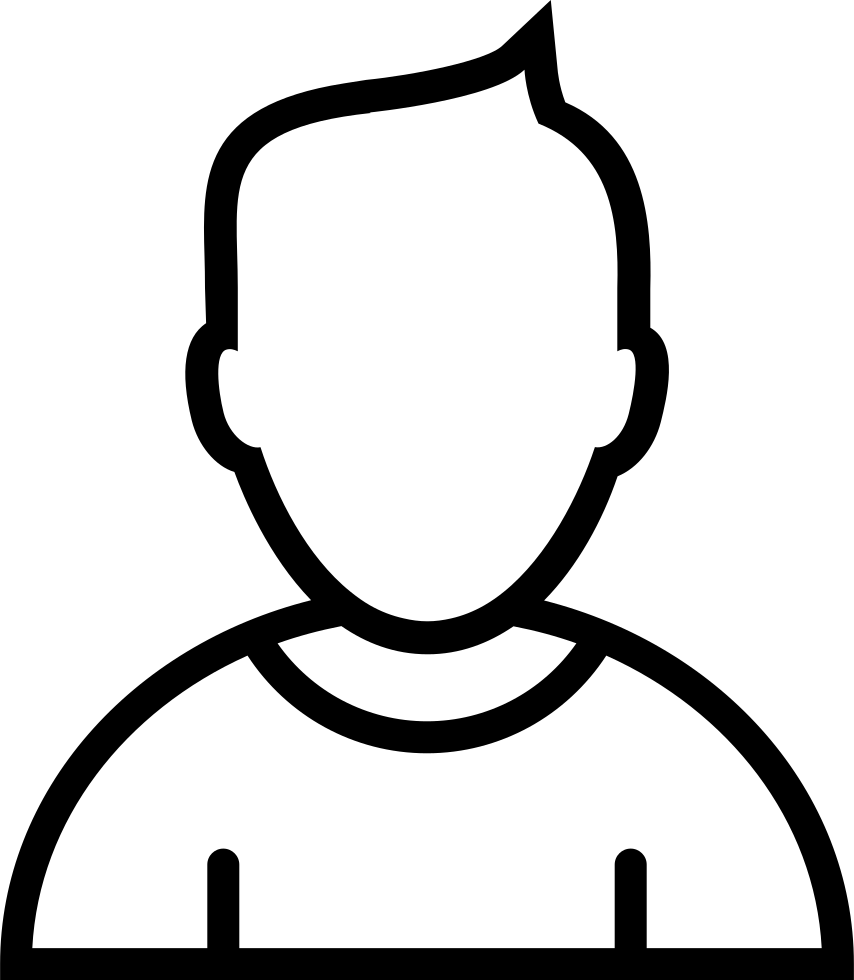
لا يوجد اقتباسات