التنشئة وجسامة مسؤولية الكبار
التنشئة وجسامة مسؤولية الكبار
الحسين بوخرطة
إن ضرورة العناية التربوية بالطفل مرتبطة بطبيعته النفسية والوجدانية، طبيعة متميزة بقوة استيعابية خارقة لديه تمكنه من التقاط كل ما يدور وما يحدث في محيطه التواصلي بسرعة كبيرة. وأمام هذا المعطى الثابت علميا، لا يسمح التعامل مع الأطفال داخل الأسرة وفضاءات التنشئة المختلفة بدون معرفة وإلمام بالعلوم التربوية والنفسية.
إن عصر الانفتاح والتقدم الفكري والعلمي والتكنولوجي، بإكراهاته وتحدياته المرتبطة بموازين القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية في العالم، لم يعد يسمح بالتماهي في تحديد الأهداف والطموحات الحقيقية في مجالي التربية والتعليم. النضال من أجل المستقبل بالبلدان العربية والمغاربية يتطلب اليوم كأولوية المراهنة بكل الوسائل المتوفرة على خلق القطيعة مع ما تمت تسميته "التغرير والتغليط الثقافي"، وذلك ببذل المجهودات الفكرية الضرورية بحس وطني قوي في كل قطر على حدة لتفنيد كل ما ترسخ من بدع وأفكار وسلوكيات واهية، تغلغلت وانتشرت في أوساطنا الثقافية، وشملت كل جماهير شعوب المنطقة من المحيط إلى الخليج.
في اعتقادي المتواضع، ما يجب أن يطمح إليه عرب ومغاربيي القرن الواحد والعشرين هو العودة بعزم كبير إلى العقل والعقلانية والعلم والروح العلمية في كل شيء يهم المعاش اليومي ويستحضر رهانات وتحديات المستقبل، بدءا من تربية أبناء الغد على أسس علمية لا تترك أدنى حظ لاستمرار المنطق التقليدي العفوي في التربية الأسرية، ومرورا بمواجهة الدعوات غير الموضوعية للرجوع إلى الوراء والدعوات الاندفاعية والانفعالية للهروب إلى الأمام (الارتماء في أحضان منطق الحضارات الأخرى)، ووصولا إلى تعميم العقلانية والقضاء النهائي على الأمية التربوية والثقافية. إنه مطلب، سهل في مظهره وصعب في تثبيت قيمه، تبرره إلحاحية حاجة أقطار منطقة انتمائنا الحضاري إلى أجيال جديدة لا تعير اهتماما كبيرا ولا تضطر لبذل المجهودات الذهنية المرهقة لابتداع الحلول الوسطية في التوفيق بين الجديد والقديم، وبين الاقتباس من الايدولوجيا الليبرالية الغربية ومن واقع المجتمعات المحلية.
إن المدخل الأساسي للتقدم في العملية التحديثية، بالخصوصية الحضارية الذاتية، وبوثيرة مقبولة، يتطلب أولا استدراك النقص في تقوية الوعي عند الأسرة بمتطلبات التربية العصرية، وثانيا الاعتراف بضرورة تدارك النقص في الممارسة التربوية. لم يعد ضغط سرعة التحولات يسمح بالتهاون في توجيه المنظومات التربوية والتعليمية نحو توفير الشروط المواتية للتحرر الحقيقي، تحرر بمنطق يسهل عملية تشكيل بورجوازيات وطنية ناشئة، بثقافة حداثية مترسخة ومتميزة، وعلى أساس الكفاءة والاستحقاق، وبقدرة فكرية وأخلاقية تؤهلها لنسج علاقات جديدة مع الآخر، علاقات تحد بشكل نهائي من تأثيرات رواسب التحالفات مع الانتهازيين أو الاستغلاليين. إنها الحاجة إلى هوية جديدة لا تتماهى مع دعوات ضياع الوقت في التفاعل أو التداول بين القوى القديمة والقوى الجديدة، ولا تتعدد فيها ولا تتشعب الالتواءات والانعراجات المفتعلة، هوية تتجه بالقوة اللازمة والسرعة الفائقة نحو الهدف مباشرة، ولا تبالي بالعراقيل والعقبات المصطنعة.
في هذا السياق، فإضافة إلى التركيز على الوسائل والآليات لترسيخ مقومات التربية السليمة وتعويد الأطفال على القراءة والكتاب ومعالجة مشكلات الكبار قبل حل مشكلات الصغار، تبقى الحاجة للوقوف عن كتب عن ما ينبغي أن يتجنبه الكبار في العملية التربوية، لضمان سلامتها ونجاعتها، ذا أهمية بالغة. فبالتربية والتنشئة المعرفية، وما يترتب عنها من جودة في إنتاج الأجيال المتعاقبة ومن دقة في التعبير عن اختياراتها في مختلف المجالات، يرتقي مفعول وأداء كل المؤسسات الخاصة والعامة والمدنية والعسكرية. على عكس ذلك، التمادي في ارتكاب الأخطاء التربوية في حق الأطفال يترتب عنه تأثير جد سلبي إلى درجة تجعل شخصيات الغد مترهلة وضعيفة في أدائها ومردوديتها وحس انتمائها الوطني. إن تعمد السياسات العمومية، بمؤسساتها وإعلامها، عدم التعاطي بالجدية اللازمة مع مشروع بناء مجتمعاتها على أساس العقلانية، يمكن أن يساهم، بفعل التراكم اليومي الفتاك، في تفاقم وتطور المشكلات السلوكية لدى أجيال الأطفال والشباب، وفي اختلال علاقتهم مع أولياء أمورهم، وبالتالي عرقلة تطور شخصياتهم بشكل سوي وطبيعي، والتأخر في دراساتهم جراء ما يسببه ضغط أخطاء الكبار من تشتت للانتباه والتركيز، ومن سوء لتوظيف الذكاء والنباهة.
وفي هذا الصدد، ينصح المختصون الآباء والأمهات والمربين بأن يكونوا باستمرار جزءا لا يتجزأ من مشكلات الأطفال بدلا من أن يكونوا جزءا من حلها. وعندما نتكلم على ضرورة توفر المعرفة والإتقان والإبداع في العملية التربوية، نعني بذلك الابتعاد الكلي عن ارتكاب الأخطاء واعتماد الأساليب الخاطئة في التعامل مع الأبناء. ومن ضمن الهفوات الجسيمة والأشد تأثيرا على نفسية الطفل، والتي يجب الابتعاد عنها كليا، نذكر:
• استخدام العنف: العنف بشقيه البدني أو المادي (الضرب، الصفع، الربط، التقييد بالحبال، والسعق بالكهرباء، والكي، ...) واللفظي أو المعنوي (السب، الشتم، التحقير، التوبيخ،...) يعد من أسوأ الأساليب الخاطئة في حل مشكلات الأبناء. أكثر من ذلك، يساهم العنف في تعقيد نفسية الطفل، ويجعله يرد على العنف الذي مورس عليه بعنف أقوى وبعدوانية مقاومة للتغيير في سلوكياته. كما يترتب عن تكرار ممارسة العنف على الطفل تقوية حدة العناد لديه والإصرار على تكرار الأخطاء انتقاما من المعاقب (الأب أو الأم أو المربي بصفة عامة). إن ممارسة العنف لا جدوى منها ولا منفعة فيها على الإطلاق، فما هي إلا عملية ردعية تخويفية لا ينتج عنها سوى نتائج مؤقتة. إن ممارسة العنف على الطفل جراء تكرار أخطائه ما هي إلا وسيلة تمكن الكبار من شفاء الغليل وتفريغ التوتر، وسرعان ما يعود الطفل إلى سلوكياته المشينة وبدرجة أقوى، وبالتالي يتعود على الازدواجية في السلوك (انفصام) حيث يلجأ إلى أسلوب "التقية" في حضور المربي، وينتفض في غيابه. وبخصوص تفاعل الطفل مع السب والشتم والقذف، أكد المختصون أن عقل الطفل اللاواعي يجعله يتصرف وفقا للأوصاف القبيحة الموجهة له، أكثر من ذلك، تترسخ هذه الصفات في سلوكياته، وقد يتصرف وفقا لها بعد ذلك. وبخصوص الصراخ في وجهه، فقد اعتبره المختصون نوعا من العنف الذي يعيق العملية التواصلية "التفاهمية" بين الوالدين وأطفالهما. كما أن تعرض الطفل باستمرار لهذا الأسلوب يفقده التركيز في استيعاب أخطائه، ويدفعه حرصه الدائم لتفادي غضب المربي إلى اللجوء إلى الكذب.
• التهرب من معرفة مشاكل الطفل: إن انشغال الآباء والأمهات عن أطفالهم ومشاكلهم، أو لجوئهم إلى الحلول السهلة العقابية في أغلب الأحيان، أو المراهنة على الزمن لحلها من تلقاء نفسها، لا يؤدي إلا إلى تفاقم السلوكيات المشينة عند الأطفال واستعصاء معالجتها مع مرور الوقت. بفعل التراكم، تتحول هاته المشكلات من طبيعتها العادية إلى طبيعتها المعقدة والمركبة والتي قد تستدعي تدخل الطب النفسي المختص من أجل معالجتها.
• الوقوع في أوضاع الانفعال الشديد: بالطبع عندما ينفعل المربي ويفقد أعصابه وثباته وهدوءه تضيع منه الكفاءة والمعرفة والعقلانية، ويضعف في تدخلاته التركيز والانتباه والتفكير السليم والقدرة على الإبداع. ولذلك، ينصح في حالة الشعور بالغضب بالانسحاب إلى أن يعود الهدوء والتركيز من جديد. بالعصبية والتوتر قد يلجأ المربي إلى الخروج عن حيز المشكلة المطروحة، بل قد يوسع دائرتها لتشمل الماضي والحاضر والمستقبل. وفي هذه الوضعية، يجد الطفل نفسه أمام تراكم حزمة من المشاكل بدون أي حلول تربوية، مما يخلق لديه حالة استياء شديدة من نفسه ومن محيطه.
• المبالغة في الوعظ والإرشاد: لقد تأكد أن الإطناب والمبالغة في الوعظ والإرشاد يخلق الملل والسأم عند الطفل. إن فرض ساعات من الوعظ والإرشاد على الطفل تشعره بالغباء، وباختلال العملية التواصلية مع الواعظ أو المرشد (الأب أو الأم أو المربي). وفي هذه الحالة ينصح المختصون، إضافة إلى اعتماد الحوار والنقاش في العملية التربوية، التقليل من الكلام عبر اللجوء إلى الاختصار المفيد (خير الكلام ما قل ودل وأصاب المضمون)، الاختصار الذي يمنح للطفل الفرص المواتية للتعبير وتقييم سلوكه بسهولة واستنباط العبرة من ذلك. كما ينصح باعتماد الإرشاد غير المباشر عن طريق الحكايات والقصص عوض الإرشاد المباشر الذي لا يولد إلا المقاومة والدفاعات النفسية داخل وجدان الطفل، وبالتالي يحرم من الاستلذاذ من التداعي الحر اللطيف.
• الخصام الطويل مع الطفل ولومه وتأنيبه والإفراط في نقده: عملية اللوم والتأنيب والنقد لا تؤدي إلا إلى إشعار الأطفال بالذنب بدون معرفة العلاج السليم لمشكلاتهم. بهذا الأسلوب لا تحل المشاكل المطروحة بقدر ما يسود النفور في القلوب والمشاعر الإيجابية بين الوالدين (أو المربين) والأطفال، وتتوتر العلاقة التربوية والتواصلية بينهم. إن اللوم والنقد المستمرين، خصوصا أمام الآخرين، يشعر الطفل بالنقص وعدم القدرة على التصرف بصواب، الشيء الذي قد يسبب له فقدان الثقة في النفس، والتعود على اللجوء إلى الآخرين قصد المشورة والتوجيه قبل اتخاذ قراراته. بالمبالغة في النقد، تعقد المشكلات ويتشتت التركيز عند المربي والطفل على السواء. أما التهديد بكل أشكاله، فهو أكثر خطورة من العقاب، لكون طبيعته الغامضة تولد القلق والخوف عند الطفل (التهديد هو التوعد بعقاب منتظر). كما أن الخصام الطويل مع الطفل، نتيجة لما ارتكبه من أخطاء، يشعره وكأنه مرفوض وغير مقبول من أعز الناس إليه (الأب أو الأم). إن مخاصمة الأطفال ومقاطعتهم لفترة زمنية معينة هو أسلوب من أساليب الهروب من المشاكل، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم المشاكل وتباعد القلوب وقسوتها. كما يسبب هذا الأسلوب كذلك في حرمان الطفل من الحب والعطف الضروريين، وبالتالي يسبب له ذلك نوع من الإحباط ونوع من الشعور بالعدوانية.
• المن والمقارنة السلبية الظالمة: بالإفراط في المن وتكراره يجد الطفل نفسه في وضعية ضعف وتأنيب نفسي ذاتي مستمر. فالطفل لا علاقة له بقرار إنجابه، وتربيته وتنشئته من مسؤولية وواجبات الأمهات والآباء. النفقة حق من حقوق الأبناء على الآباء لكي لا يشعرون بالحرمان والدونية والنقص، ولكي لا يلجئون إلى السلوكيات الخاطئة (كالسرقة مثلا) لتلبية حاجياتهم اليومية. كما أن اعتماد أسلوب المقارنة السلبية للطفل بغيره لتأنيبه لا يحل المشكلة المطروحة بقدر ما يبعد الجميع عنها. بالمقارنة السلبية للطفل المخطئ بأطفال آخرين وبخاصة إخوته (أخوه الصغير على الأخص) ترتفع حدة الغيرة والحقد والحسد والبغضاء بينهم.
• سحب الثقة من الابن: أساس تقوية العلاقات بين بني البشر تنبني على الثقة. وعليه لا يمكن نجاح الوالدين في تربية الأطفال بدون أن تكون العلاقات السائدة داخل الأسرة تنبني على الثقة القوية المتبادلة. إن شعور الطفل بعدم ثقة والديه فيه يسبب له ذلك، مع مرور الوقت، فقدان الثقة في نفسه، ويترسخ في ذهنه أنه مهما التزم بالسلوكيات الجيدة، فإن ذلك لن يمكنه من نيل رضاهما وكسب ثقتهما فيه.
• التهديد بالطرد أو الطرد من المنزل: مجرد التهديد المتكرر بطرد الطفل من المنزل تجعله يشعر بعدم الأمان والاستقرار، وينتابه شعور بالخوف والقلق المستمر، الشيء الذي يدفعه إلى التفكير في حماية نفسه من خلال الاستعداد وتوفير شروط الهرب من المنزل قبل أن يتخذ في حقه قرار الطرد التعسفي (جمع المال بالسرقة مثلا). وعند طرده الفعلي من المنزل، يشعر الطفل أنه طرد من قلوب والديه وإخوته والناس أجمعين، وبالتالي يسقط في حالة الاكتئاب الدائم، ويكون في آخر المطاف فريسة سهلة للوقوع في الإدمان كوسيلة للتهرب من واقعه ومن آلامه ومعاناته وشعوره بالذنب، وعرضة للميول إلى الانحراف والإجرام بفعل تأثيرات أصدقاء السوء في الشارع.
• الدعاء بالسوء على الأبناء: الدعاء بالسوء والمصائب على الطفل يعتبره هذا الأخير كراهية له. ويتمخض على هذا السلوك تباعد القلوب واختلال التواصل وكراهية الطفل لنفسه، ومضاعفة حدة المشاكل لديه واستعصاء حلها.
خاتمة:
ما من شك أن الخروج من وضعية الاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية بالبلدان العربية والمغاربية، دولا ومجتمعات، يتطلب باستعجال التجند بالقوة اللازمة من أجل إعادة الاعتبار للأسرة والمدرسة كمؤسستين اجتماعيتين أساسيتين مهمتهما تربية الأجيال وتعليمهم وإعدادهم لمواجهة الحياة بتحدياتها ورهاناتها. فإضافة إلى ضرورة الوعي بما يجب أن يتجنبه الكبار من أخطاء في التربية المنزلية، يتطلب الأمر تنمية القدرات المعرفية والمادية والمعنوية للأسر بالشكل الذي يمكنها من تهييء أطفالها للدراسة الابتدائية (تعميم التعليم الأولي ومدارس الحضانة)، ومن مساعدتهم بمختلف الطرق والوسائل خلال مراحل دراستهم. إن وضع الأسرة في منطقتنا العالية لا زال مقلقا نظرا لتدهور أوضاعها المادية والثقافية والمعرفية. أغلب الآباء والأمهات يضطرون للخروج إلى البحث عن لقمة العيش طوال النهار وفي ظروف صعبة، الشيء الذي يمنعهم عن القيام بمراقبة أبنائهم في الدراسة وتقديم المساعدات الضرورية لهم، هذا علاوة على عدم توفرهم على السكن اللائق والمستوى المعرفي المطلوب. الوقت المتسارع بتطوراته لا يرحم ويفرض باستعجال اللجوء إلى ربط التشريع بالممارسة في التربية والتعليم بالتطبيق السليم للمنع القانون لاستعمال العنف ضد الطفل في الأسرة والمدرسة وفي كل الفضاءات العامة والخاصة بشقيه المادي الجسدي أو المعنوي (حمل الطفل على رفع الأيدي على الجدار، أو إخراجه من القسم، أو سبه وشتمه،...). فالعملية التربوية لا ولن تستقيم ما لم تتوفر مجموعة من المقومات في شخص المربي، تجعل منه قدوة عند الأطفال وعند أفراد المجتمع، والتي نذكر منها: الاتزان النفسي، والاستبصار والحكمة والصبر والإيجابية، والثبات والقدرة على التحكم في الذات، والثقة في النفس والالتزام بالتفاؤل والأمل، القدرة على اتخاذ القرارات السليمة، والقدرة على التواصل والتفاوض وتحمل المسؤولية، والاستعداد الدائم للعطاء والإبداع والتعاطف والحب والشعور بمشكلات الأطفال والرغبة الدائمة لحلها،...إلخ.
تقييم النص
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد ! كن أول المعلقين !

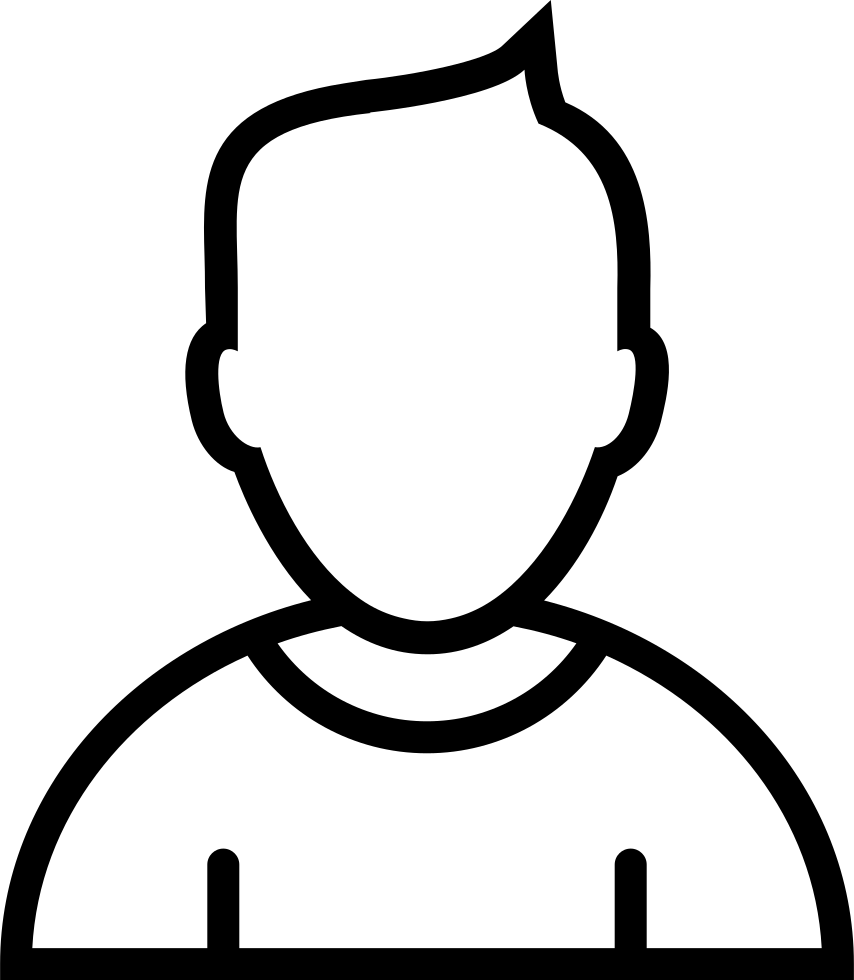
لا يوجد اقتباسات