تحدي الوقت مغربيا
تحدي الوقت مغربيا
قراءة في القصة القصيرة "الساعة" للدكتور علي القاسمي
بقلم الحسين بوخرطة
مجريات أحداث قصة "الساعة" احتضنها بلا شك التراب المغربي برمزيته ودلالته التاريخية وخصوصيته الثقافية والسياسية في زمن اشتداد التفكير في بناء الدولة العصرية. فمن جوهر صداقة نبوغ جمعت السارد بسيدي محمد، أينع نموذج رجل عبقري، ناضل بكل جوارحه وفكره باحثا عن تأصيل معالم نمط حياة متميز كونيا لتدبير الوقت. تميز عمله بالإقدام الخالي من المخاطرة والمغامرة، ونجح في تقديم درس ثمين للعرب بصفة عامة وللمغاربة بصفة خاصة في مجال متطلبات الوجود الفردي والجماعي في بحر سيولة زمنية لا ترحم. لقد تحمل في يومياته، التي كانت استثنائية بكل المقاييس وخارجة عن المعتاد، عبء تناقضٍ قابلٙ تآلُف "الرضا/التوجس" في مواقف الأفراد والجماعات في تاريخ حضارة عريقة "الغرابة مجسدة في رجل ... كان مثل طير متميز اللون يحلق بعيدا عن السرب في أعالي السماء".
قد يقول قائل أن سيدي محمد دفع الثمن غاليا بأسلوبه الدقيق، وحرصه الشديد والمتواصل لتقديم أنموذج يقتدى به في التعاطي مع آفة سيولة زمن مسمومة أنهكت مصير أمة. كان يخدمه رجل أصم، ولم يسمح لنفسه تعذيب امرأة (زوجة) بطقوس حياة قاسية وقواعد أسلوب حياة صارمة بمنطقها الرياضي. إنه مشروع خاص/عام عبر عن عظمة شخصية مغربية، مدركة تمام الإدراك أن تحمل أصوات ساعاتها المختلفة والمتنوعة غاية في الصعوبة. فالأحداث كما رواها السارد لا يمكن أن يتحمل مشاقها المضنية بتجلد وصبر إلا عظماء النفوس. قدم تجربة صعبة للغاية، بل معقدة ومستعصية التخيل والفهم والإدراك. هي معركة رجل أكاديمي مثقف وينبوع إنسانية متدفقة، استحضر باستمرار الترابط القوي بين المطلب التاريخي لتدبير الوقت ومردودية نماء الشعوب العربية والمغاربية. لم يكل ولم يمل طوال عقود حياته من مصارعة دقات ساعاته التاريخية التي تكسو فضاءات وجدران دارته، ومن التسابق مع ثوانيها محدثا توازنا خارقا بين التفكير والتنفيذ والحصائل. حرصه الشديد والدائم على الالتصاق بأسلوبه، وما سببه له من معاناة نفسية وصحية، جعله يغادر إلى دار البقاء في سن العطاء والمردودية.
تطرقت القصة إلى موضوع هام جدا وحساس للغاية، يزرع التفاؤل في النفوس. تمحورت فقراتها حول معادلة معقدة، قابل الكاتب من خلالها عالم عربي إسلامي زاخر بالطاقات الوطنية ومنطق ديمقراطي سياسي بتمثيليات تعبث وتستخف بالوقت مبتعدة عن هموم وانشغالات الجماهير، لتصيبها العاهات المزمنة والتآكل والضعف في مكامن قوتها التاريخية. فقدت مع مرور الأيام القدرة على استغلال الثروات الطبيعية لأوطانها وتثمين كنوز رأسمالها اللامادي، وتسخير الروح الترابية وغناها لخدمة ونماء شعوب المنطقة من الخليج إلى المحيط.
أعطت هذه القصة للدكتور علي القاسمي صورة واضحة لولوجه مناخا حكائيا متميزا. استحضر أمجاد المشرق العربي، ونبه في نفس الوقت إلى الثراء المعرفي المغاربي، والمكانة التاريخية للفكر المغربي في مجال البحث عن مرتكزات النهضة الإقليمية والجهوية. فنموذج سيدي محمد ما هو إلا تجسيدا لخصوصية المغرب الأقصى في ماضيه وحاضره.
وعليه، خطاطته السردية خرجت عن المألوف. في وضعية البداية، ترك للقارئ تحديد دلالات المكان والزمان. تجاوز الأحداث العادية لوضعية البداية، وانتقل بسرعة بمتواليات القصة ومقاطعها إلى وضعية الوسط بعناصرها المخلة، ليختمها بدون العودة إلى السكون والهدوء. القارئ للقصة يجد نفسه أمام عتاب للنفس، يبحر في كدر وحزن عميقين، مجابها أسئلة أوضاع معقدة ومتشابكة تأبى أن تستسلم لعنصر الانفراج. تجاوز كذلك عنصر الاختزال المكاني والزماني مانحا العبرة النهائية ثراء في الإفادة، جاعلا منها رسالة أجيال، ومحولا إياها إلى إشكالية مصير شعوب منطقة برمتها. الخصائص الفنية لهذه القصة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من قصصه الأخرى، جعلت حبكاته السردية تتجاوز السمات النفسية والاجتماعية، لتترعرع مراميها السياسية ببلاغة راقية. قوة صداقته مع سيدي محمد أعطت لأسلوب سرده رؤية من خلف.
من الواضح أن القاسمي قد أسهب في كتاباته في وصف التعارضات والتناقضات الصارخة بين الحضارتين العربية والغربية أو الأمريكية. لكنه لم يقم بذلك انحيازا أو لزخرفة نصوصه بعبارات الإثارة النفسية. اعترف بالتفوق الحضاري للغرب (الحرية، الانعتاق، العلوم والتقنيات،...)، لكنه في نفس الوقت تفوق في الوقوف على مكامن ضعفه (التفكك الأسري والمجتمعي، والتحلل، وتفاقم مؤشرات الانحطاط، والإفراط في الثقافة الإستهلاكية،...). فالغرض من دعوته في القصة إلى الاقتداء بسيدي محمد، كأرقى تجربة لتعاطي إنسان عربي إسلامي بوطنية مغربية مع الوقت، لا يمكن أن يكون منفصلا عن انشغاله بتقديم مشروع نهضوي عربي ومغاربي جديد، يتأسس على سيادة أقطار قوية تنتصر لقيم التحرر والانعتاق والتماسك والتضامن وسيطرة منطق العلم ونظرياته، وتحتكم ثقافة شعوبها إلى الطب العصري والتكنولوجيات والأنماط التدبيرية الحديثة والإبداعات الأدبية والفلسفية. فالتدبير العقلاني للوقت هو السبيل الفريد للرفع من وثيرة تراكم المعارف وبالتالي تنوير العقليات وتهميش المحافظة والشعوذة والدجل والخرافات.
إنها قصة غنية بأسلوبها اللغوي وشروحاتها المستفيضة ومرادفاتها الجذابة وإثارتها لتطور معاني الألفاظ والمصطلحات زمنيا وجغرافيا، ومقاصدها المعبرة عن قضية أمة.
الطابع العلمي للقصة، دفع الكاتب إلى التقليل من استعمال الحواس، إلى درجة إهمال هذا الجانب. فباستثناء إثارة قليلة لحاسة البصر في مدخل النص، أفرغت باقي فقراته من ذلك. لبس السارد شخصية البطل، وغاص في صفحات التاريخ لإبراز القيمة الحضارية لتدبير الوقت. فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. إنها الحكمة التي دفعت الكاتب إلى ربط التحكم في المورد الزمني بالأبعاد النفسية والتربوية والسياسية والثقافية، وبآفاق الاستقرار والنماء السياسي والاقتصادي والثقافي.
إن الدعوة إلى تحريم هدر الوقت أخلاقيا وقانونيا يجب أن تستهدف كأولوية رجال التربية والتعليم في مختلف أسلاكه ورجال الإدارة بمسؤولياتها الجسيمة، وكذا كافة المنشطين في مختلف مؤسسات التنشئة الموازية. فلا مناص من تحفيز هذه الطبقة المتنورة والمسؤولة على التحلي بالاتزان والحزم والوطنية وتقديم القدوة للمتعلمين والمتدربين والمرتفقين. إنها الوسيلة المثلى لمحاربة التردد والتذبذب والخوف وضعف التركيز والانحراف في نفسية شخصيات الأجيال المتعاقبة. فمقاومة الانحراف والإجرام داخل المجتمعات العربية (على غرار أحداث قصتي "المشاكسة" و"النجدة" لنفس الكاتب)، تتطلب ترسيخ علاقة وثيقة بين قيمة الزمن، كمورد نفيس ومحدود لا يقبل التخزين وإعادة الاستعمال، وقيمة المنتوج التربوي والتنموي كما وكيفا.
سيدي محمد، هو بطل القصة، وشخصية حقيقية من الرجال الوطنيين بالمغرب. إنه رجل أكاديمي جاد في عمله، وحريص على تدبير الوقت بنجاعة ومردودية تامتين. لقد اعتبر تفشي الاختلال في تدبير هذا المورد، الثمين والعجيب بخاصياته في نفس الوقت، الآفة الأكثر فتكا بحاضر المجتمعات العربية الإسلامية ومستقبلها. شديد الحرص على التفاصيل، تعوﱠد على استغلال ثواني دقائق حياته في العمل الجاد. رجل ملتزم في معاملاته ومهامه مجسدا في حياته القيمة القصوى لحركية عقارب ساعاته المختلفة والمتنوعة. كان قيد حياته حكيما، لا ينطق إلا بالكلام الوازن، ويحسن الاستماع للغير. معاشرته كانت بمثابة انخراط في مدرسة حياة فسيحة: "التقيتُ به بعد أن التحقتُ أستاذًا بكلِّيَّة الآداب. كانت عيناه تشعّان ذكاءً لا يُفصِح عنه فمُه، فقد كان قليل الكلام، كثير الصمت".
يعتبر سيدي محمد نموذٙج نخبة وطنية من العيار الثقيل، وأمثاله كثر، لتبقى إشكالية قابلية وقدرة المنظومات السياسية التمثيلية والإدارية على استيعاب وإدماج شخصيات المعارف والخبرات في مناصب المسؤولية القيادية وامتصاص كفاءتهم من أعقد الإشكاليات في العالم العربي الإسلامي. مصادر الشرعية السياسية لا زالت بها تتذبذب ما بين الولاء للسلطوية والقبيلة والغنيمة والعقيدة والزبونية وخدمة الريع، مهمشةً بذلك القدرة المعرفية والتخصصات العلمية المتنوعة والخبرات التدبيرية.
في هذا السياق، كشف السارد بجلاء كيف تقاوم المنظومات المجتمعية العربية، بثقافاتها المحافظة ذات الدوافع الواهية، وعاداتها المفبركة، وبمعطياتها التي تراكمت في صفحات التاريخ السياسي والثقافي المتلازمين، الصرامة والجدية والشفافية والعقلانية في الفعل والقول على المستويين العام والخاص. كما أفشى كيف يتم الانقضاض على الفوائد بهذا السلوك ظلما وعدوانا. فكلما ازدادت لدى المتلقين والمتفاعلين نسبة النضج والتراكم المعرفي، وارتفع عددهم، كلما تكاثفت جهود إحداث الانزلاق والتغرير والاستقطاب، وبالتالي وأد الإرادة الإصلاحية في أيام ولادتها الأولى. لقد ترسخ التطبيع ثقافيا مع المصلحة غير الشرعية، وشاع النظر بتلذذ وريبة إلى الغنيمة والمحرمات بدافع الأنانية والانحراف. في نفس الآن، اشتد الاحتراس من العناصر المسؤولة الجادة والكفأة، بحيث لا يتم تحويلها إلى قدوة إلا بعد غيابها أو تغييبها أو تهجيرها أو مغادرتها دار الفناء إلى دار البقاء: "لم أحتَجْ إلى طويلِ وقتٍ، لتلتقط أُذناي ما كان يتهامس به زملاؤه عنه. كانوا يقولون إنّه غريب الأطوار، غريب الأفكار، غريب الذوق والسلوك والهوايات، يصعب على طلابه أن يفهموه بسهولة. كلماته رموزٌ، وعباراته ألغازٌ بعيدةُ المرامي. يجمع المتناقضات في عقله، وتلتقي الأضداد في شخصه".
شدة إلمام سيدي محمد بالتاريخ العربي الإسلامي زمن الأنوار، وما راكمه من تراث ثقافي ثقيل تكلس بفعل تسلط منطق تحكمي طامح في ديمومة استمراره، جعلته يتحدى الواقع ومحبطاته بخبرته وثراء معارفه، مجابها بشجاعة وتميز التعودات التقليدية بخنوعها وكسلها وكسادها، آملا أن يكون وقع ذلك إيجابيا ونفعيا على طلبته وأصدقائه " يدرِّس الأدب الإنكليزيّ، ولكنّه خبير في التراث العربيّ القديم. كان مثل طيرٍ متميِّزِ اللون، يحلِّق بعيدًا عن السرب في أعالي السماء".
لم يتهاون قط سيدي محمد في التعبير عن ذلك بجلاء ووضوح تام ودائم في أقواله وأفعاله وسلوكياته. أعجب به السارد، ليقابله سيدي محمد باطمئنان وانفتاح، لتتحول علاقتهما إلى صداقة معرفية وأخلاقية، ترعرعت وأينعت وخلقت فضاء صداقة ونبوغ. لقد تيقن من أصول ومعدن السارد، ومن حرصه على احترام الوقت. ارتاح له، وفتح له دارته. فعكس ما كان يعتقده الحاكي، أتحفه بمعلومات قلﱠ من يتوفر عليها. لقد أفاده أن العرب القدامى كانوا سباقين إلى استيعاب معنى الوقت واختراع أدوات حسابه وتتبع تقسيماته ودوراته: "الساعة أروع ما اخترعه العقل البشريّ. ويعود الفضل لأجدادنا العرب القدماء. لا أقصد بالساعة الآلة أو الأداة، وإنّما الوحدة الزمنيّة. فالعرب البائدة من السومريِّين والبابليِّين والفراعنة هم الذين توصَّلوا إلى تقسيم الزمن إلى سنواتٍ وفصولٍ وشهورٍ وأسابيعَ وأيامٍ وساعات، عن طريق مراقبة الكواكب والنجوم، وتقسيم الزمن الذي تستغرقه في كلِّ دورةٍ من دوراتها ... إن كلمة "فنجان" (جوابا على إعجاب السارد بفنجان قهوته قائلا: هذا فنجان لطيف على شكل ساعة) كانت تُلفظ " بنكان". واستُعلمت كلمة "بنكان"، في التراث العربيّ، لتدلَّ على نوعٍ من الساعات ذات الآلات الميكانيكيّة. والفنجان الذي ترتشف القهوة منه الآن يقوم بالوظيفتَيْن. فعندما تنتهي من شرب قهوتك تستطيع أن تقرأ فيه الوقت الذي استغرقتَه في الشرب".
تشبع سيدي محمد بما دونته صفحات التاريخ في موضوع الأهمية القصوى التي كان يوليها العرب القدامى لقيمة الوقت، وتحول لديه هاجس ترسيخ ثقافة تدبيره في المجتمع أفرادا وجماعات إلى تحدٍ يرفعه أينما حل وارتحل. لقد تفاعل مع السارد معترضا بلطف على اعتقاده وتجرؤه على انتقاده بصورةٍ غير مباشرة متهما إياه بالهوس في تعاطيه مع تدبير الوقت، ضانا (الراوي) أنّ أجدادنا العرب القدامى لم يحفلوا بالوقت كما نحفل به اليوم، فبعيرهم في الصحراء لا يعبأ بالوقت، كما تتقيّد به طائراتنا اليوم: "على العكس تمامًا، كانت معرفتهم الدقيقة بالوقت تعوّض عن ضعف وسائل الاتصال والمواصلات عندهم. وكان من حرصهم على الوقت أنَّهم خصّصوا اسمًا لكلِّ ساعةٍ من ساعات الليل والنهار. فأسماء ساعات النهار الاثنتي عشرة، مثلاً، هي: الذرور، البزوغ، الضحى، الغزالة، الهاجرة، الزوال، الدُّلوك، العصر، الأصيل، الصبوب، الحُدُور، الغروب. سردَ تلك الأسماء بطلاقةٍ متناهيةٍ، حسدتُه على خفَّةِ لسانه فيها"
تعلق سيدي محمد بقيمة الوقت ودورها في بناء الشخصيات والحضارات عبر الأزمنة والعصور وفي مختلف المناطق الجغرافية. فضبط المواعيد والتركيز على الأهم في تبليغ الرسائل والعبر في لقاءاته وعروضه ومحاضراته جعله لا يقبل الأعذار في ضياعه. الوقت بالنسبة له ارتقى إلى درجة القداسة والسمو وجوهر الوجود الإنساني على سطح هذه البسيطة: "وصل أحد الطلاب الجُدد إلى قاعة الدرس متأخِّرًا عشر دقائق. ولمّا لم يكُن يعرف الأستاذ ولا الطلاب، فقد طَرقَ الباب وسألَ الأستاذَ: هل هذا هو قسم الأستاذ سيدي محمد؟ أجابه لا، فدرسه بدأَ الساعة الثامنة."هكذا أجاب الأستاذ بشكل طبيعي...انصرف الطالب الجديد خائبًا، ولم يُدرك معنى ضحك الطلاب الذي لاحقه، ولكنَّه علم، بعد ذلك، أنَّ الأستاذ سيدي محمد قد لقَّنه درسه الأوَّل بصورةٍ لا وفحواه: احترمْ المواعيد، تقيَّد بالوقت، فالوقتُ من ذهب ... لولا الوقتُ، لما صار الإنسان إنسانًا".
حوﱡل بطل القصة منزله إلى مدرسة وفضاء ثقافي في مجال تدبير الوقت بالدقة المتناهية، بحيث كان لا يسمح بالدخول إليه إلا لمن يستحق ثقته بعد تيقنه من احترامه لأثمن ثروة في تاريخ البشرية. من يلج هذا الفضاء يعتقد أنه أمام متحف للساعات التاريخية. كان مولعا بجمع الساعات للتعبير بصدق تام عن تشبثه باحترام الوقت، والحرص على تجسيد ذلك في ساعات يومياته. فهو يحمل دائما ثلاث ساعات في آنٍ واحد. وأحيانًا، يحمل بضع ساعات أُخرى في بقيَّة جيوب بذْلته "ولعلَّ سلوكه هذا هو الذي دعا زملاءَه إلى وصمه بتهمة الغرابة".
فضاءات وجدران بيته مزينة بالساعات التاريخية بدقاتها السمفونية، ولكل ساعة خاصياتها في الصنع والفائدة والحقبة الزمنية: "باحة المنزل غاصَّةً بحشدٍ غريبٍ عجيبٍ من الساعات القديمة والحديثة... في وسط المنزل كانت ساعةٌ مائيّةٌ تحتلّ مكان النافورة... وفي أعلى الحائط المقابل نُصِبتْ ساعةٌ شمسيّةٌ كبيرةٌ... عُلّق على الجدار إسْطُرْلابان كبيران، أحدهما نحاسيّ والآخر فضيّ ... لمحتُ على منضدةٍ في زاويةِ باحةِ الدار ساعةً رمليّةً مؤلَّفةً من قارورتَيْن زجاجيتَيْن كبيرتَيْن مُتَّصلتَيْن بعنقٍ صغيرٍ... كانت بقيّة الجدران مكتظَّةً بالساعاتِ الحائطيّةِ من مختلف الأنواع والأحجام والأشكال: ساعة حائطيّة ببندولٍ طويلٍ يتدلّى منها ويتراقص يمينًا وشمالًا، وساعة حائطيّة رقّاصها على شكل طير يزقزق الدقائق ويُطلق صيحات بعدد الساعة، وساعة حائطيّة تنفتح من وسطها بين ساعة وأُخرى فيخرج منها تمثالُ رجلٍ صغيرِ الحجم ليعلن الوقت بصوتٍ أجشَّ ثُمَّ تنغلق عليه. لوحةٍ خشبيّةٍ كبيرةٍ معلّقةٍ على الجدار، وهي تحمل اثنتي عشرة ساعةً جيبيّة. وكانت بقية الجدران مكسوَّةً بالساعات الحائطيّة المختلفة؛ والطاولات في الغرفة مليئةً بالساعاتِ المنضديّة المتنوِّعة. وكانت دقّاتها تختلط في سمفونيَّةٍ غريبةٍ من الأصوات، والأنغام، والإيقاعات. في المطبخ نصبت لوحةِ الساعات الجيبيّة المعلَّقة على الحائط. كانت تشتمل على اثنتي عشرة ساعة جيبيّة. كلُّ ساعة كُتب تحتها اسم مدينة من مدن العالم ابتداء من الشرق إلى الغرب، بحيث يكون الفرق ساعةً واحدةً بين كلِّ مدينة وأخرى: طوكيو ، كوالالمبور، بانكوك، إسلام آباد، دلهي، مكة، طرابلس، تونس، الجزائر، الدار البيضاء، إلخ".
العجيب أن موقع كل ساعة بغايته لم يكن اعتباطيا أو عشوائيا، بل كان له وظيفة دقيقة في حياة البطل. علاقة اختيار الأمكنة بوظيفة الساعة كانت وطيدة جدا. لتبيين ذلك بجلاء، كان جوابه عن سؤال السارد في شأن الغاية من سبع ساعات من نوع واحد مفصلا ومقنعا: "إنّها ليست من نوعٍ واحد. فالأولى تعمل باللولب، والثانية تعمل بالبطارية، والثالثة بحركة اليد، والرابعة بنبض المعصم، والسادسة بالطاقة الشمسية، والسابعة بحركة الهواء. أضف إلى ذلك، أنَّ كلَّ واحدةٍ منها تقوم بتنبيهي إلى أمرٍ مختلفٍ، بنغمةٍ مختلفة ... كانت الساعات المختلفة الجداريّة والمنضديّة والجيبيّة واليدويّة تقرع، بين آونة وأُخرى، أجراسًا وجلاجل متباينة الأنغام، متنوِّعة الإيقاعات".
وبمرور الزمن، اكتشف السارد أنّ حياة الأستاذ سيدي محمد البطل تتحكَّم فيها أجراسُ ساعات تضبط مهامه وانشغالاته ومواعيده بالدقة المتناهية: "جرسٌ يوقظه من نومه في الفجر لأداء صلاة الصبح، وجرسٌ آخر يقرع ليدخلَ المغطس في الحمام ويستلقي في مائه الدافئ المريح، وجرسٌ آخر يُخرجه من الحمام، وخامسٌ يُجلسه على مائدة الفطور، وسابعٌ ينبّهه إلى الخروج في اتّجاه الكُليّة. وجلجلةٌ خفيفةٌ من إحدى ساعتيْه اليدويَّتَين تسترعي انتباهه إلى التوجُّه إلى قاعة الدرس، وجلجلةٌ من الساعة اليدوية الأُخرى تذكّره بانتهاء الحصّة، وهكذا دواليك".
تشبث سيدي محمد بالوقت وولعه بالساعات جعله يختار حياة خاصة وغريبة في نفس الوقت ثائرا على واقع مستخفٍ بالزمن: "كان يعيش وحيدا بدون امرأة ترعاه، فليس هنالك امرأةٌ تستطيع أن تعيش وسط ذلك العدد الهائل من الساعات الدقّاقة ذات الوظائف الدقيقة. يخدمه رجل عجوز مصاب بالصمم لكونه تعلم واعتاد التواجد داخل بيت البطل بمجريات حياة منظمة، إلى درجة أصبح خبيرا في قراءة شفاه لمعرفة تعليماته ومراده."
نموذج البطل نادر للغاية، وصناعة نمط حياته الدقيق بتفاصيله، والغزير بمنتوجاته وأدائه ومردوديته وعبره، لا تتاح إلا لذوي النفوس القوية. حرص طوال حياته على أن يكون قدوة لمحيطه ومعارفه. أخضع ممارساته ومهامه وانشغالاته لأصوات ساعات مختلفة ومتنوعة. لقد نجح في خلق نموذجٙ حياةٍ تناغمت فيها الآلة بالسلوك وباحترام تقسيمات زمنية غاية في الدقة.
والحالة هاته، لا يمكن لمن حالفه الحظ بمعرفة سيدي محمد أن لا يفكر في ارتباطات تخلف البلدان العربية الإسلامية بسوء تدبيرها للوقت. فطموح المؤسسات الرسمية والمجتمعية في النماء، وعلى رأسها المؤسسة الأولى في التنشئة (الأسرة)، لا يمكن أن يتحقق إلا بتحويل كل فضاءات التربية والتعليم والتنشئة إلى مجالات لتدبيره الناجع.
قد نجد هاته المقاربات التدبيرية بأنماطها الجديدة مفعلة نسبيا في الدول المتقدمة شمالا، وتطبق بمستويات لن ترقى أبدا إلى قداسة ومكانة وأهمية الوقت في حياة بطل القصة. إنه قدوة في عالمٍ عربٍيٍ فسيح الذي لا زال ناسه بعيدين كل البعد عن هذا الانشغال الجوهري في تاريخ البشرية.
مرض الأستاذ سيدي محمد، وتوقفت أنشطته، وصمتت كل تلك الساعات. لقد توقّفتْ عن قرع أجراسها. طال مرضه، ودام صمتُ ساعاته شهورًا. فارق الحياة. وكانت جميع الساعات تقرع أجراسها بشكلٍ متواصلٍ، نواحا على فقدان رجل قدوة. ضاعت الساعات كآلات، واشتد القلق على الاستخفاف بالوقت كمورد ثمين، ومن الزيادة في سعة الهوة ما بين الشرق والغرب.
لقد جسد سيدي محمد الشخصية النموذجية كونيا في تدبير الوقت. اعتبره بدون انقطاع موردا ثمينا، وطبق في ساعات أيامه أساسيات تدبيره العقلاني. احتكم في قضاياه وانشغالاته اليومية إلى التحليل الدقيق، والتخطيط المتنور، والتنظيم المحكم، والمتابعة والتقييم الدائمين. كانت كل تحركاته تجسد حرصه الشديد على الاستغلال العقلاني لهذا المورد الناذر والمحدود، الذي كان وراء حصائلة القياسية ومردوديته المبهرة. لقد أبرز النص ببلاغة كبيرة كيف جسد سيدي محمد بتحد نموذج رجل يحتدى به بجدارة واستحقاق. تعلق بهوس شديد بالتفكير في طبيعة هذا المورد الطريف وهو يحدد أهدافه اليومية، ويرتب أولوياته، ويصارع أسباب تذليله (الزيارات المفاجئة العقيمة، المبالغة في الترفيه، التأجيل المستمر للأهم، التهرب من المسؤولية، العجلة، عدم الصبر، النسيان، والإهمال،....). من المؤكد أنه كان يعتبر دنيا الفرد والجماعة مجرد فضاء له بابين، بينهما زمن لا يرحم المستخفين به، يدخل الإنسان من الأول ويخرج من الثاني.
لقد جسد البطل في سلوكيات حياته بالملموس الحديث النبوي الشريف: "لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمر فيما أفناه، وعن شباب فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما نفقه، وعن علمه ماذا عمل به".
أما البعد الإنساني الإضافي في القصة فيتجلى في المشاعر والإحساسات الفياضة للقاسمي وارتباطه القوي مع أصدقائه الأوفياء. فكلما فقد صديقا، كان يحزن لفراقه بشدة، ولا يرتاح إلا بعدما يرثيه بنثر صادق، أو يؤبنه بقصة رائعة، مسجلا بذلك اسم الفقيد في تاريخ الإبداع والفن. فما أحوج نخب شعوبنا إلى الإقتداء بسلوك القاسمي وسيدي محمد.
تقييم النص
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد ! كن أول المعلقين !

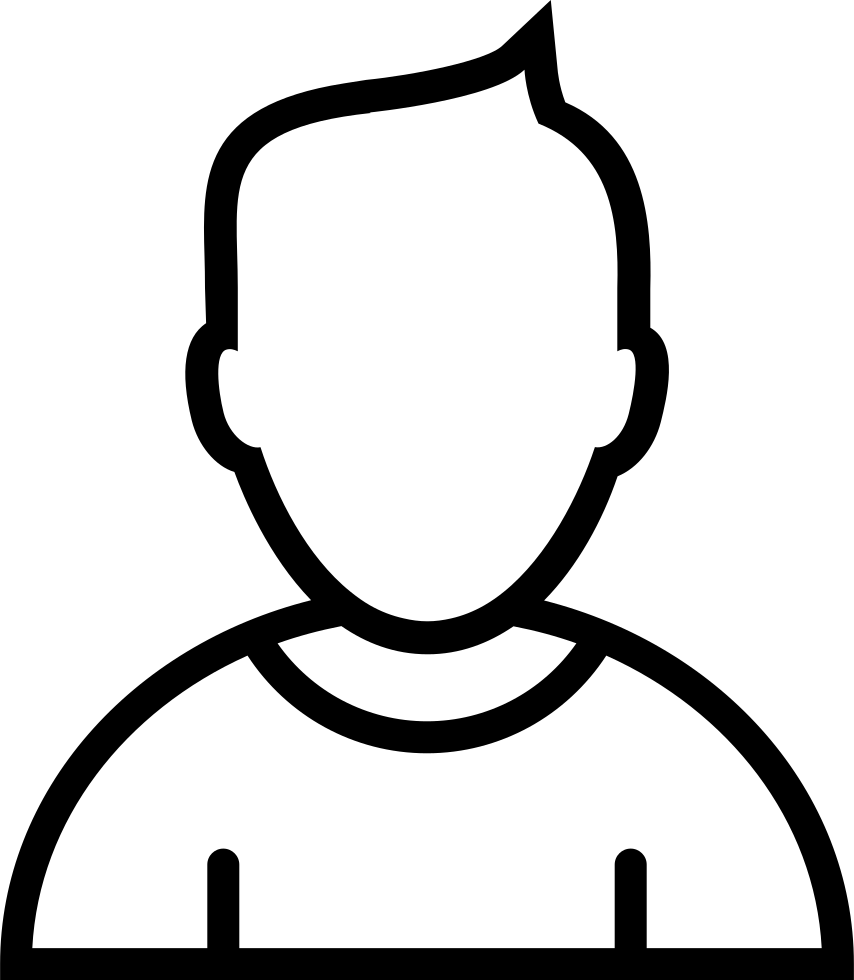







لا يوجد اقتباسات