تحولات حضارية ومخاطر الانزلاق إلى الهاوية
إن التحولات السريعة التي يعرفها العالم زمن ما بعد الحداثة لا يمكن ألا تكون دافعا لدى كل الفاعلين والباحثين في دول الجنوب بشكل عام، وفي دول الشمال بشكل خاص، للتفكير اليومي في مدى ارتباط السياسة والعلوم بمصلحة المجتمعات الآنية. إنه الدافع الذي تزداد بفعل طبيعته حدة القلق في النفوس في شأن المستقبل الإنساني للمجتمعات قطريا وكونيا. إنها تحولات تبرز وكأن الرأسماليين يقومون بتحويل الحضارة الإنسانية، بدون إعلان ذلك بالمباشر، وتحت غطاء الليبرالية السياسية (الديمقراطية) والاقتصادية (العولمة) والثقافية (الحرية والحقوق والحداثة)، في اتجاه انزلاق سياسي وعلمي في خدمة الأقليات والسلط المتحكمة في المؤسسات الدولية والوطنية الرسمية وغير الرسمية.
إن عالم اليوم يعيش علاقة تتوطد باستمرار بين العلوم، خاصة العلوم التكنولوجية (Techno-sciences) بمختبراتها المتعددة، والاقتصاد بأسواقه الجغرافية والافتراضية، ورجال السياسة، بحيث أصبحت ثقافة المعرفة مرتبطة بثقافة المعلومة، وبالسلطة المؤسساتية، تحت شرط قابليتها (أي المعرفة) للتحول إلى ثروة إنتاجية مهمشة للتفكير الفلسفي (Richesse productive). إنه واقع جديد بتداعيات مقلقة تمس بشكل مباشر معيش الطبقات الهشة والفقيرة. لقد تمت ملامسة ذلك عن كتب من خلال الحوارات التي أجريتها مع عدد كبير من الفلاحين والحرفيين والصناع والتجار والعاطلين عن العمل في مختلف المدن الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة. لقد أكدوا جميعا أن المنتجات الصناعية، التي كانوا يختصون في إصلاحها أو بيعها (الغسالات، وشاشات التلفاز، والسيارات ....)، أصبحت تكنولوجيا لا تقبل أي تدخل حرفي، ولا تحتمل أي صيانة أو إصلاح خارج مقرات مصنعيها الأصليين (إصلاح بتشخيص آلات المسح الضوئي). فبعد انقضاء مدة الضمانة، وإعلان لوحة القيادة الوصول إلى آخر يوم من مدة الصلاحية (مدة الحياة المتوقعة بالكيلومترات أو السنوات) تتحول المنتوجات إلى نفايات تكنولوجية يعاد تصنيعها من جديد في إطار التنمية المستدامة. أكثر من ذلك، موازاة مع استمرار إعلانات إفلاس الوحدات الإنتاجية بسبب التفوق التكنولوجي والتدبيري للشركات والمقاولات الكبرى، أصبحت دول الجنوب تعاني من إغلاق محلات الصناع والحرفيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة بسبب الإقبال المتناقص باستمرار على منتجاتهم وخدماتهم.
حتى على المستوى التربوي والتكويني، أصبحت مردودية الأجيال الصاعدة، ونجاحهم والفائدة من أدائهم، مرتبطة بمدى قدرة الأفراد والجماعات على تحويل معارفهم إلى ثروة ملموسة، ثروة تكنولوجية أو سمعية بصرية أو إعلامية وإشهارية أو منهجية،..... وبذلك لم يعد للتربية والتعليم التقليديين أي مكانة لا في سوق الشغل، ولا في الاستراتيجيات المؤسساتية الخاصة والعامة. الاقتصاد التكنولوجي الذي اكتسح العالم لم يعد يحتمل اليد العاملة كقوة عمل عضلية، بل أصبح لا يطيق إلا الموارد البشرية القادرة على تحويل، أو المشاركة في تحويل، النظريات العلمية إلى منتجات قابلة للاستهلاك والنفاذ في الواقع، أي في الأسواق العالمية. فتكريس ظاهرة استنساخ المعدات والآلات التكنولوجية مباشرة بعد ابتذال أو إنهاك التي سبقتها في الإنتاج، مع استحالة تدخل الحرفيين والصناع في إصلاحها أو ترميمها، أصبح يثير الذعر والقلق ويزعزع المعتقدات جراء ما يروج من حين وآخر من رسائل جريئة تروج فكرة تجاوز عمليات الاستنساخ مجالات الصناعة والفلاحة لتمتد إلى البشر (استنساخ الأذكياء والناجحين) القادرين على الإبداع في أبحاثهم لسبر أغوار أسرار الأرض والكون على السواء.
لقد أثر هذا الإشكال على نفسية شعوب الأقطار الجنوبية، وتحول إلى مصدر تذمر وقلق وخوف. إنه الوضع الذي يتطلب اليقظة والنضال بسلط إنسانية مضادة من أجل التثبيت الثقافي للمسؤولية الأخلاقية للعلوم من أجل تحقيق مواطنة كونية ضامنة لمقومات العيش المشترك بكرامة وسلام وطمأنينة. إنه النضال الذي يجب أن يكون مؤطرا بشعار الحفاظ على الشرعية الإنسانية للعلوم المختلفة، شرعية تجعل العلوم، كما كان في السابق أي في عصر الأنوار، الحامل الأساسي لمشعل التنوير الثقافي، وبالتالي تحويل المرحلة الحرجة التي يعيشها عالم اليوم إلى مرحلة أكثر اطمئنانا ووضوحا بمعارفها العلمية والفيزيائية والجغرافية، مرحلة جد متقدمة بخاصية التطور المستمر الذي يمتد عبر الزمان والمكان بدون فرامل أو عراقيل من الشمال إلى الجنوب.
خلاصة
إن تحقيق هدف تقوية الشرعية المجتمعية للعلوم المختلفة كونيا، بتعدد مجالاتها وتخصصاتها، لن يزداد إلا استعصاء ما لم تبادر الدول، خصوصا في الجنوب، إلى تقوية الديمقراطية التنموية (وليس الرقمية الكمية) وتحويلها إلى قيمة ثقافية مجتمعيا توطد العلاقة بالقوة اللازمة ما بين الحاكم والمحكوم. فتنشيط الحيوات العامة والخاصة جنوبا يبقى مرتبطا إلى حد بعيد بمدى استعداد الروح الجماعية للأوطان لتكوين رأي عام متشبث بحقه في الفهم، وحقه في أن يصبح قوة عارفة وعالمة وواعية برهانات وتحديات المستقبل. إنها الحاجة إلى الروح الجماعية المقاومة للظلام والظلمات والتحكمات والخضوع لمنطق المسايرة اليومية. إنها الحاجة الاستعجالية لروح مدعمة بقوة كافية تنبعث من تفاعلاتها قدرات تمكن الموارد البشرية من اكتساب مستوى كافي يؤهلها لطرح التساؤلات الضرورية باستمرار، وفي الأوقات والمراحل والأماكن المناسبة، وبالتالي اكتساب القدرة على التحرر والانسلاخ عن الأوضاع والأفعال والخطابات غير الواضحة، وعلى الانخراط القوي والجدي في ورش الحداثة غير المنتهي، والتكتل لحمايته من الانزلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.
تقييم النص
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد ! كن أول المعلقين !

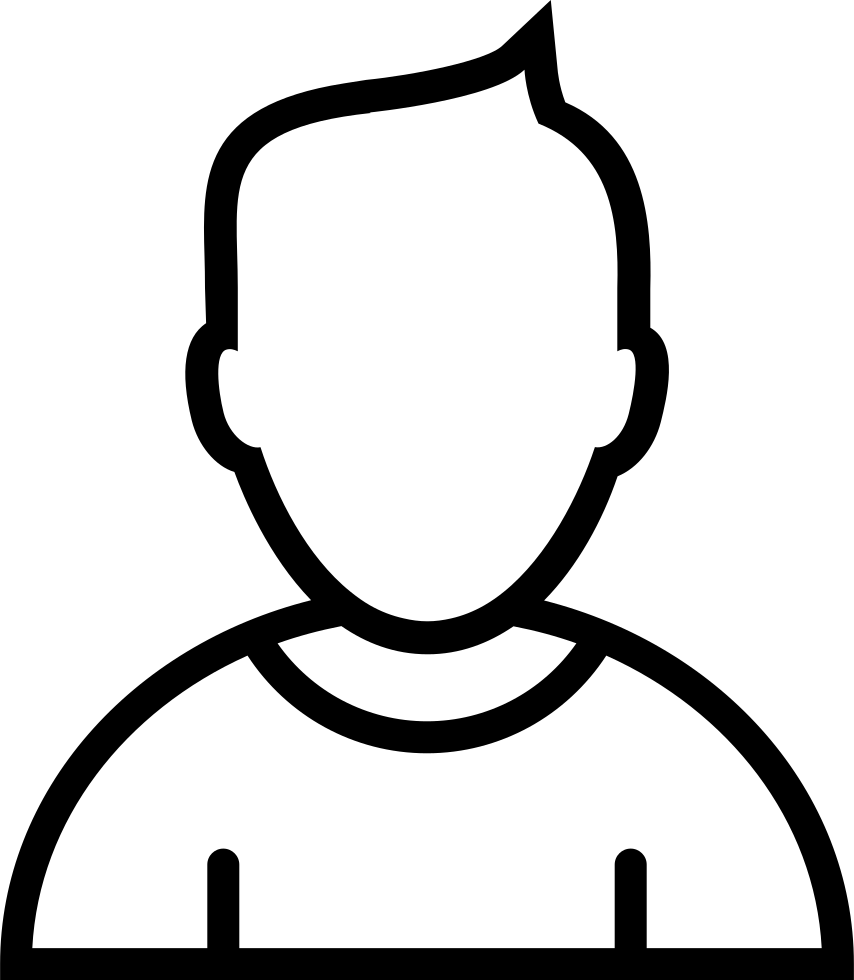
لا يوجد اقتباسات