قراءة نقدية للقصة القصيرة "النداء" للدكتور علي القاسمي
نموذج صداقة نبوغ عربي بالمغرب
الدكتور علي القاسمي، العلامة الموسوعي الملم بعمق بخبايا المعارف المختلفة والمتنوعة، يعتبر اليوم مرجعا ثريا زاخرا بمقومات بناء مشروع عربي وإسلامي بأمجاد تاريخية وحضارية. بصفوة تفكير وتأمل، تعمق في أصالة الماضي ومعاصرة الحاضر، ورمم ما تم ردمه من قيم حضارية لامعة، وما تم الزج به عمدا خارج الأعراف والممارسة. كل من أتيحت له الفرصة لقراءة إحدى قصص مجموعاته الخمس، يجد نفسه مشدودا لفكرة البحث عن نبذة تعريفية لهذا الأديب وإبداعاته الحكائية.
اهتماماته المتعددة مكنته من ثقافة واسعة وعميقة، جعلت نصوصه الفكرية والأدبية تحمل المتعة والمعرفة في آن واحد. أدرك بعمق كنه الحضارة الغربية والعربية وسر التطورات الكونية، وامتد مسار دراسته من بغداد ولبنان إلى فرنسا وبريطانيا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إنه مسار ثري بمعارفه وشخوص محيطه، مسار توج من خلاله متخصصا في علم المصطلح وصناعة المعجم، واكتسب بذلك الريادة في اللسانيات والنقد والقصة والرواية والترجمة والتنمية البشرية.
من أجل ضمان الديمومة في إغناء الشكل الزلال لكتابات القاسمي ومضمونها الثري، لم يتقاعس يوما في عجﱢ تراكمات إبداعاته بركائز تراثية عريقة ونافعة، وانتقاء تيمات إنتاجاته الأدبية بعناية فائقة، مخصبا إياها بالأبعاد السياسية الوطنية والاجتماعية والثقافية والفنية والفكرية والتربوية واللغوية والنفسية والفلسفية والعلمية.
تشجيع الأجيال على القراءة، بالنسبة للقاسمي، يتطلب الابتعاد عن التعقيد والأسلوب السجع لعدم تلاؤمه مع روح العصر، والاحتكام للأسلوب الحداثي الصرف. تناول بحبكاته السردية الراقية مشمول القضايا الجوهرية للأمة العربية كالتربية والتعليم، والقيم الوطنية والمدينة والقرية، والأسرة والطفولة والشباب والمرأة، والتكافل الاجتماعي،... أعطى لتفاصيل دروس وعبر رسائله الهادفة والمستفيضة أهمية كبيرة، إلى درجة أصبحت تعبيراته الشيقة والسلسة والمثيرة للانتباه مصدر تأويلات عديدة ومتعددة، ليساهم وضوح لغته في تيسير مقروئية نصوصه واستيعابها... في نفس الوقت، لم يتقاعس في كتاباته إلى التنبيه من مخاطر العاهات المجتمعية كالفساد والشعوذة والخرافة والانحراف والتحرش الجنسي،... مركزا على ما يتطلبه الصراع الحضاري ما بين الشرق والغرب من نباهة وحذر وحكمة، مقدما تصورا متكاملا لمعالم موضوعية جديدة للتعاون شمال/جنوب.
إنها الدوافع التي جعلت الكاتب يولي عناية خاصة للعلاقات الاجتماعية، منبها إلى الحاجة إلى تدارك الهدر الزمني في مجال الوعي بأهمية الوقت أسريا، وعلى مستويات الفرد والجماعة والمجتمع والمؤسسات. الرهان بالنسبة له يتجلى في إيماءاته الحكائية القوية التي تجعل من التعبير الرسمي الدائم للحكومات القطرية عن إرادتها الراسخة لتأصيل ثقافة تقدير الوقت وتدبيره، كقيمة ثمينة لا تحتمل بطبيعتها إلا من يتشبث بضمان استغلالها الناجع، بطموح الرفع من مردودية السياسات العمومية والخاصة إلى أعلى المستويات.
فإلى جانب كل ما تطرقنا إليه من أفكار وأهداف ومرامي نبيلة في قراءتنا السابقة للقصة القصيرة "الساعة"، معتبرين الوقت موردا ثمينا وناذرا وغير قابل للتعويض، تبقى ترجمة هذا المبتغى على أرض الواقع، بمستويات عالية وبيسر، مرهونة إلى حد بعيد بتوفر الشروط الموضوعية لإحياء وتعميم مفهوم الصداقة، وتقوية التآخي والتعاون والتضامن بين شعوب المنطقة من الخليج إلى المحيط.
إنه الرهان الصعب الذي جعل القاسمي يخصص له قصة واقعية كاملة عنونها "النداء". إنها حكاية موضوع هذه القراءة النقدية، والتي أطمح من خلالها إبراز السمو الحضاري لمفهوم الصداقة كركن أساسي وحيوي لبناء مشروع نهضة عربية وإسلامية. لقد برهنت صفحات التاريخ كيف يكون التواصل والتفاوض بين الأصدقاء مفيدا للغاية. التآخي يضمن ديمومة التفاعل البناء ويحمي تواصل المتفاوضين والمتفاعلين من الضب والطائلة والغليان.
إن ما عاشه ويعيشه العالم العربي من استهداف منذ عقود، وما يتوالى على المغرب الأقصى بخصوصيته السياسية والثقافية من هجومات غير مبررة في السنوات الأخيرة، دفعت القاسمي، غير ما مرة، إلى دق ناقوس الخطر. إن يقظة الدولة المغربية وتقدمها الواضح في تنفيذ مشروع نماء ترابها الوطني بخطى حثيثة في إطار الاستقرار، تحول اليوم بالواضح إلى مصدر إزعاج للدول المتقدمة الغربية.
إن الدعوات المغربية لاستنهاض الهمم، وما ترتب عنها من تراكمات في مجال الوطنية والتنمية، ومن تطور للشخصية المغربية المعتزة بجذورها وأصولها التاريخية، ومن استعداد جماعي لمواجهة مخاطر العولمة وحبالها المتشابكة وتهديداتها المستقبلية، ومن ارتقاء للأدوار الجديدة للبلاد إقليميا وقاريا، جعلت الغربيون يمتعضون من هذا النماء المتصاعد. لقد أحسوا بالملموس، وعبروا عن ذلك بشكل غير مباشر في عدة مناسبات، أن السياسة بالمغرب أصبحت تتغذى بتفاعل لافت من المشاريع الفكرية لرواد الحركة الثقافية والفلسفية والأدبية والعلمية (مشاريع علي القاسمي، محمد عابد الجابري، عبد الله العروي، محمد سبيلا، محمد أركون، وعبد الكبير الخطيبي، وحسن حنفي ....).
كل المؤشرات تنم بتقدم المغرب في بحثه المتواصل عن السبل لتقوية الثقة وترسيخ قيم التعاون والتضامن والإخاء والحب والكرم ونجاعة الفعل التنموي داخل الوطن وفي علاقاته مع دول الجوار. في نفس الوقت، لم يعد خافيا على أحد، ما تبذله مؤسساته من جهد لتنويع وإثراء تقاطعاته البناءة مع الدول العربية والإفريقية، وما تتحمله من أعباء مادية ومعنوية لترسيخ ثقافة تدبير الوقت، وتمتين الصداقات الجهوية بين الأفراد والجماعات والمؤسسات على أسس قومية وتاريخية.
على هذا الأساس، ارتقت القصتان "الساعة" و"النداء"، المعبرتان عن قدرة إبداعية هائلة للكاتب للتعبير عن أحداث سيرته الشخصية، إلى فضاء فكري رحب تنبعث منه رسائل تربط مستقبل المنطقة بضرورة ترصيص الصفوف لمواجهة التحديات والرهانات والطوارئ المرتبطة بها. فعلاقة سيدي محمد بالكاتب في القصتين ارتقت بحمولتها الإنسانية إلى مستوى نموذج راق (انصهار العراق في المغرب) لإبراز حقيقة التقارب الطبيعي ما بين شعوب الدول العربية بأبعاده الثقافية والعقائدية والتاريخية والحضارية.
لقد جعل الكاتب من تعبيرات نص قصة "النداء"، التي أمزج فيها بمنطق التلازم سمو صداقة نبوغ عربية بامتياز، فضاء للوفاء والمحبة الصافية. شكلت معاشرة السارد لسيدي محمد فضاء حياة دافئة، وألفة دائمة، ودعم وحماية. لقد جعل القاسمي من هذه القصة منبرا معرفيا لتبليغ رسائل بعبر في غاية الأهمية. لقد استعمل أسلوبا أدبيا يتسم برقي سام، وجاذبية مسترسلة من أول كلمة فيها إلى آخرها.
مضمون القصة، بأحداثها الشيقة، ينم عن قوة ارتباط الكلمات والعبارات بأحداث حياة السارد. أمام دقة الوصف، ورقة الأحاسيس وعلو جلالها، وشرف المواقف ونبلها، لا يمكن للقارئ أن يتملص مما يتوالى على مخياله من كلمات رنانة مؤثرة وجدانيا، وهو يتقدم في قراءته المتأنية لمحتواها. سمت الصداقة إلى التحام روحي قوي ودائم. إنه الالتحام الذي لا يمكن أن يتبدى من خلاله إلا كون مجمل الأحداث المشوقة للقصة الواقعية قد بصمت بقوة حياة الكاتب/السارد كأكاديمي مغترب، أعجب ببلد إقامته واندمج في دفئ كرمه وصداقاته. فبالرغم من دوام حنينه وشغفه لمعانقة تراب بلاده العراق، لا يكل ولا يمل في التعبير بصدق تام كونه لا يعتبر نفسه مغتربا بالمغرب. فهو وطنه الثاني الزاخر بثقافة عربية إسلامية عريقة، عاش في دفئها لأكثر من خمسين سنة، مندمجا بقوة مع شعب كريم أصيل نبيل.
معلوم أن للدكتور علي القاسمي أصدقاء كثر، وتجمعه معهم وفرة العواطف والمحبة والاعتزاز. كما أن تعلقه بقداسة الصداقة، وارتباطه كعالم بضرورة تقاسم المعارف ومناقشتها، دفعه إلى فتح موقع إلكتروني على الشابكة سماه "أصدقاء الدكتور علي القاسمي". وهو يعتبر الصداقة الصادقة تغذية للروح والعقل، نجد في محيطه، المتفاعل بقوة وباستمرار مع الأحداث القطرية والجهوية والعالمية، عدد كبير من الأصدقاء بانتماء ترابي يشمل المستويات العربي والمغاربي والدولي، أصدقاء من طينة الأدباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين والنقاد وخبراء العلوم الدقيقة والفلاسفة والفنانين.
شمخت وارتقت دارة سيدي محمد بأفضالها إلى مرتبة عظيمة بروعتها المبهرة، وتعاليها الطبيعي، ونبلها الزاخر بالقيم الإنسانية الصافية، ومجدها المهيب، وفخامتها الممتعة، وغبطة لحظات المكوث فيها. إنها الملاذ الآمن للسارد. فيها تسمو ألفته، وتتحقق شروط راحته النفسية والروحية.
وسيدي محمد قيد الحياة يناضل من أجل ترسيخ قيم العيش المشتركة، لم ينكر صديقه الحميم (الراوي) انقضاض الغربة والنكد عليه كغيمة سوداء من حين لآخر. فعندما يغتم ويتضايق، لا يجد سبيلا يسلكه داخل الشبكة الكثيفة للطرقات المؤدية إلى معارفه إلا ذاك المتجه إلى منزل سيدي محمد. إنه الصديق الأقرب إلى روحه، والمداوي لأحزانه وكربه، والملطف لمزاجه: "فقد كنتُ، قبل وفاته، كلّما ضاقت نفسي وشعرت بالغربة تهبط على روحي مثل غيمة سوداء، أسرعتُ إلى شقَّته دون موعدٍ سابق، فكان يفتح لي الباب مرحِّبًا باسمًا مسرورًا، ويُكثِر من الترحاب بي، ويسألني عن أحوالي. ثُمَّ يتّجه إلى المطبخ، فيضع إبريق الماء على الموقد لإعداد الشاي، ويملأ صحنًا بقطع الحلوى المغربية: كعب الغزال، المحنّشة، القطايف، ثمُّ ننقل كلَّ شيءٍ من المطبخ إلى غرفةِ الجلوس، ونشرع بالحديث وتناول كؤوس الشاي بالنعناع مع الحلوى. وبعد ساعةٍ من حديثه الحلو المليء بالنوادر والطرائف، أشعر بالارتياح، كما لو كان ذلك الإحباط الذي أثقل روحي قد انزاح شيئًا فشيئًا، حتّى غدا قلبي خفيفًا يستطيع مسابقة الريح".
تحولت معاشرة سيدي محمد للسارد، بقيمته الأكاديمية والعلمية، إلى فضاء لجوءه المفضل، فضاء بمستويات دفء إنساني. لا يتخلص من وحشية غربته وقساوة أحزانه إلا عندما يتجاوز عتبة دارته. إنها مقومات صداقة نبوغ خاصة، ترعرعت بفعل إلمام السارد بقواعد المعاشرة بقيم عربية حضارية، وخبرته الكبيرة وتنوع تمثلاثه لمعاني القرابة والصداقة في مختلف ثقافات المجتمعات شمالا وجنوبا.
الكاتب، وهو يحكي على لسان السارد أحداث القصة، عبر بمفاهيم وازنة متتالية أنه لا يطيق إلا الصداقات الطاهرة والمفيدة ثقافيا وفكريا وإنسانيا وأدبيا وفنيا وعلميا. بالنسبة له، الحداثة الإنسانية، والإيمان بالمستقبل، والتأثير إيجابا على مجريات التاريخ، لا ترتقي وتتحول إلى أهداف دائمة التفعيل والمردودية إلا عندما تتلاقى وتتقارع وتتناقح أفكار روادها المنتمين لمشارب الشعب العلمية والفكرية والأدبية والفنية.
لقد أثبتت هذه التجربة النموذجية أن بالصداقة والإخاء تتوسع فضاءات الإبداع والجمال والإمتاع والمؤانسة والمذاكرة المعرفية وقوة الاحتماء المشتركة. فما أحوج شعوب دول الجوار لهذا النوع من الفضاءات الإنسانية للتعمق في إبداعات السلف، واستنهاض التقاليد الحميدة المنعشة لعقل الحضارة العربية الإسلامية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والسلم والنقاش الهادئ والإيمان بالاختلاف والجدل اللطيف.
إن الالتزام بقيم الصداقة والتآخي أصبح شرطا أساسيا للنهوض بالأوضاع العربية والمغاربية. كما أن تحويل أم اللغات، اللغة العربية، إلى قاطرة تستجيب للمتطلبات والحاجيات المصطلحية المسهلة لاختراق التراث بعقلانية، والتمكن من الآليات المنهجية لغربلته وفصل الرداءة عنه، أصبح من أولوية الأولويات. فتشجيع الأجيال على عادة القراءة، والغوض بهم بوعي شديد في بحر الأقوال والأمثال والحكم الأدبية والفكرية والأخلاقية التاريخية، وتنمية قدراتهم على التكيف مع التطورات العلمية والثقافية الكونية، لا يمكن تحقيقه إلا برقي اللغة الأم وازدهار الترجمة.
إن حدث وفاة سيدي محمد بالنسبة للحاكي هو إغلاق تعسفي لملاذ أكاديمي في بلاد الغربة والأنس المداوي. لقد لجأ الكاتب إلى اعتماد التكرار لتأكيد ما أحدثته منية صديق العمر في روحه من مآسي وحسرة وضيق للأفق. لقد تم تكرار كلمتي "الوحدة والغربة" أكثر من مرة مصحوبة بكلمتي "مهرب وملاذ"، ومضيفا عبارة قوية المدلول "لا أعرف بمن أحتمي" للتعبير عن قوة الصداقة والتآخي في حياة الإنسان. هذه الكلمات بعباراتها الوازنة لم تدرج في النص من أجل تأثيثه، بل هي تعبير نفسي صادق عن مكانة الصديق الذي يفي بكل شروط الصداقة الصافية (أخوة، إفادة، تنوير، حوار هادئ، ثقة، عشرة، تضامن، تعاون، حماية، تبادل النصح، الدفاع على المصلحة المشروعة المتبادلة، ...). سيدي محمد، بمكانته المؤسساتية والأكاديمية والعلمية، كان الملاذ المفضل والوحيد بالنسبة للسارد.
قد أجرؤ وأعتبر أن الاختيارات والخيارات ومساحات الحرية المتاحة للكاتب، وهو السارد المغترب في نفس الوقت، أملت عليه الاحتكام إلى الروية والحكمة والحذر واليقظة في الحديث مع الناس وفي اختيار الأصدقاء بالمغرب، معتبرا أن "لا شيء أسوء من مرارة الخيبة بعد ثقة عمياء". لقد أكد أن حقه في الكلام والتعبير لا تستوفي شروط الحرية بالكامل إلا في الحالة التي يكون في حضرة سيدي محمد وأمثاله، الرجل الطيب، الملتزم بقيم المروءة كما تربى على ذلك منذ الصبا: فبعد تطور علاقتهما بشكل سريع وملفت، أصبح سيدي محمد توأم روح صديقه وأعز إنسان لديه بالمدينة " لم أكُن أستطيع أن أُفضي بمكنون قلبي للآخرين، أو أكاشفهم بآلامي وآمالي وما يثقل روحي. أمّا سيدي محمد فقد كنتُ أحسبه واحدًا من أهلي، أطمئن إليه ويطمئن إليّ، وأرتاح إليه كما يرتاح إليّ. وكان التفاهم بيننا تامًّا. لعل ظروفنا المتشابهة وأحوالنا المتماثلة هي التي يسّرت ذلك التواصل بيننا. فقد تربَّينا في عائلتيْن محافظتيْن، وتعلّمنا في مدارس متشابهة، وتخصَّصنا في موضوعاتٍ متقاربة، وزاولنا مهنةً واحدة". تحول بيته إلى منفذ دائم له للترويح على النفس والاحتماء من براثن الضيق والغربة والوحدة "فقد كنتُ، قبل وفاته، كلّما ضاقت نفسي وشعرت بالغربة تهبط على روحي مثل غيمة سوداء، أسرعتُ إلى شقَّته دون موعدٍ سابق".
إن تعبيرات السارد الجذابة في هذه القصة تقر أن وضعه لم يكن مريحا للغاية نتيجة ثقل انشغالاته بمشروع نماء الأقطار العربية. في كتاباته تكررت مرارا عبارات المعاناة والتأوهات المشوبة بحنينه لبلاده. ربما لولا صداقته مع سيدي محمد ما استطاع استئناف حياته وأشغاله ما بين محنة وأخرى: "فأنهض مستئذِنًا بالانصراف لأعود إلى أشغالي. وهنا تثور ثائرته، لأنّني لم أبقَ معه ما فيه الكفاية، أو كما كان يقول محتجًّا: ما سلّم حتّى ودّعا".
عاش الراوي استبداد الخوف على مصيره خلال فترة مرض سيدي محمد، وكذا خلال السنة التي عقبت فقدانه. لم يجد أمامه من منفذ آخر سوى تسليم أمره لله وتعزية نفسه. عاش فترة ألم وعذاب ووحدة حتى وهو محاط بعشرات الأشخاص.
ببراعة العباقرة والرواد والخبراء في الحياة، عاد السارد إلى مجرى أحداث يومياته متسلحا بقوة شخصيته. إنها القوة التي دعا ويدعوا من خلالها الناس إلى التزود بالقدر الكافي منها لتستحق الحياة أن تستمر وتعاش.
مرت سنة كاملة وهو يكابد المصاعب، متشبثا بحق العودة إلى الحياة العادية. استحضر الكآبة المزمنة التي فتكت بكبار الكتاب والمفكرين، وغاص في تجارب ومحن عمالقة الفكر والآداب والثقافة، ليختلي بنفسه على شاطئ البحر عازما على تدريبها على تجاوز محنته. لقد نجح في صرف ذهنه عن مأساة الفقيد. كرر التمارين والتداريب بوتيرة متواصلة إلى أن وطأت قدماه بر الأمان. عاد إلى المدينة، عاد لمشاغله ومشاريعه. عاد مركزا على الحاضر والمستقبل ومتطلباتهما. لقد نجح في تجسيد الحكمة القائلة: "التفكير الزائد في خيبات الماضي يجعل حياتك كئيبة جدًا، لذلك لا تقتل لحظاتك بالتحسّر، وعِش حياتك سعيدًا لأن الأيام لا تعود".
استحق السارد، عن جدارة واستحقاق، أن يخرج منتصرا من مأساته النفسية. تشجى على سريره، وأغفته عبارات رواية "جارات أبي موسى" للكاتب المغربي أحمد التوفيق. نام نوما هادئا، فداهمه حلما جميلا. حبه العارم لصديقه، الذي غادره إلى دار البقاء، أدخله فترة جديدة ومحيرة في نفس الآن. وجد نفسه في المنام بين واجب الاستجابة لطلب الفقيد بجمع مقالاته في كتاب واحد، والخوف من العودة إلى دارته في مدينة شفشاون، وتعريض نفسه لخطر انقضاض براثن الحزن والمآسي عليه مجددا. لقد برهنت القصة أن الحياة بأفراحها وأحزانها كلها تجارب مفيدة، تجعل الإنسان أكثر خبرة وصلابة، وتعلّمه من هُم الطيبون ومن هم السيئون.
لقد أبرز الكاتب بفنية كبرى القيمة الإنسانية والحضارية لقوة الصداقة الحقيقية بين الناس. فوفاة سيدي محمد بالنسبة له أحدثت ارتباكا بليغا في أحداث يوميات حياته. لقد أبرزت الحبكة السردية القيمة السامية للصداقة الصافية، صداقة معرفية وعقلانية ووجدانية. ارتقت بشكل طبيعي إلى أعلى المستويات الحميمية والكرم والجود. إن فقدان نعمة هذه الصداقة الفريدة من نوعها والمتميزة، حولت حدث الوفاة إلى خسارة وتيه بليغين "أحسستُ بالوحدة تحاصرني من جميع الجهات، ولم يَعُد لي مهربٌ منها ... صحيحٌ أنّ لي كثيرًا من المعارف الطيِّبين فيها، ولكنَّني لم أشعر تجاه أيٍّ منهم بما أشعر به من رفع الكلفة مع سيدي محمد". فسيدي محمد كان جميلا وماهرا وعبقريا، يعرف كيف يصنع الابتسامة على محيى السارد كلما علم أنه في حاجة لذلك. يضحك في وجهه بطريقة تشعره أن أوجاع الحياة انتهت.
إنها علاقة أخوية تربط مثقفا وأستاذا جامعيا مع أكاديمي عراقي بارز. مقوماتها المشتركة نابعة من طبيعة الشخصيتين، ولها صلة وثقى بظروف تاريخهما الشخصي ومقومات تنشئتهما الاجتماعية. وهو يتابع المرض يفتك بصديقه الحميم، وتعبيرا على اعتزازه بقوة هذه الصداقة الاستثنائية، لم يكن يفكر أثناء تلك اللحظات العسيرة إلا في مآل حياته بعد أن يسلم الصديق روحه لبارئها "أُخفي دموعي عنه لئلا أزيده حزنًا على حزن. ولعلَّ حزني ذاك كان من قبيل الأنانيّة، فقد كنتُ أتوقع ما سيحلّ بي من وَحدةٍ وغربةٍ بعد رحيله ... عزيّت نفسي قائلاً لا مفرَّ من الموت وكلُّ النّاس وارده. ولكنّني بقيت أشعر بالوحدة، حتّى عندما أكون محاطًا بعشرات الأشخاص".
تعمد الكاتب كذلك في حبكته السردية أن يبرز قيمة إنسانية أخرى ميزت معاشرته للفقيد. فبالتسلح بالحكمة والصبر نضمن سلامة المحيط والراحة النفسية. لقد أوضح مفارقات ومتناقضات تكتنف السلوك البشري، مبرزا بتعبيرات غير مباشرة أهمية الإنصات وتقبل الاختلاف. الصداقة والمعاشرة لهما أسرار أخرى عديدة ومتنوعة تنبعث منها وتتفاعل من خلالها علاقات سلط جدابة بقوى متباينة شدة ووقعا. لم يحب السارد سيدي محمد كشخص فقط بل أحبه كوطن يفتخر بالعيش في أحضانه ولا يرضى بالإقامة في غيره.
تنبعث من القصة كذلك دروس أخرى. صداقة عالم بعالم، صداقة قوية بطبيعتها وخاصياتها. الرجلان لا ينظران إلى العالم نظرة عادية، بل يتأملون داخله كفنانين، وخارجه كعلماء، وباطنه كشعراء، وظاهره كرواد تجربة وعلم، ويعتبرونه وجودا واحدا حيا كعباقرة الخيال البديع المرصن للأخلاق.
بهذه الرؤية المتزنة، تضمنت فقرات القصة دعوة إلى عدم الاستسلام للتذمر والأحزان والمآسي، والسعي الدائم لابتكار كل السبل الممكنة الميسرة للتكيف النفسي مع المحن ومعضلات الحياة ومتطلباتها بدون الاستسلام لحدتها وشدتها ونوعها (وتستمر الحياة). إنها دعوة للحيلولة دون تحويل آثارها إلى كآبة دائمة وضياع قاتل. لقد برر الكاتب عبر تجربته أن مجال الثقافة والمعرفة، الذي يتطلب استمرار التفكير والتأمل لساعات في القضايا والإشكالات المختلفة والمتنوعة التي تهم الإنسانية، يعد ملاذا آمنا ووصفة شافية لتجاوز الإختلالات النفسية التي تحدثها مثل هذه المحن المباغتة "هناك درّبتُ نفسي على أن أصرف ذهني عن مأساة صديقي سيدي محمد. كنتُ أُغرِق نفسي في التفكير بأشياءَ أُخرى، بمشاريعَ ثقافيةٍ يحتاج الإعداد الذهني لها ساعاتٍ طويلة. وبعد التمرين المتواصل على صرف التفكير إلى المستقبل بدلاً من الماضي، هنّأتُ نفسي على نجاحي في ذلك وعدتُ إلى المدينة".
كما أن المتأمل في مجريات هذه القصة، بعد استيعابه لرسائل قصة "الساعة" لنفس الكاتب، سيهتدي باقتناع تام أن الانطباع أو الشك لا علاقة له باليقين، ولا يرقى ليكون مبررا لخندقة الأشخاص وتفييئهم بين خير وشرير بدون إدراك لما يخالجهم من مشاعر ومواقف وقيم. فسيدي محمد، الذي كان زملاؤه يتهامسون عنه، ويوصف بالغرابة في الأطوار والذوق والسلوك والهوايات، ويصعب على طلابه أن يفهموه بسهولة، لم تكن مكانته الحقيقية عند طلبته وزملائه بتلك الأوصاف القدحية. لقد استطاع بتأثيره وحبه الفياض أن يجعل السارد ينسى الآخرين جميعهم. في نفس الآن، فشل الآخرون أن يفرقوه أو ينسوه وجود الفقيد قيد حياته وبعد مماته. لقد أبانت الأحداث بعدما غادر سيدي محمد رحاب الدنيا أنه كان من أعز وأكفئ الأكاديميين عند طلبته ومحيطه الجامعي.
حلم السارد حلما بهيجا. التحق بصديق عمره في قصر واسع ومثير بمروجه الخضراء، وسواقيه المترقرقة، وأشجاره الباسقة، ووروده وأزهاره الزاهية، وطيوره الخلابة المزقزقة والمغردة. وجده جالسا في حديقة تشبه "جنة العريف". رحب به كالعادة، وتعانقا عناقا حارا، وطلب منه جمع كتاباته عن المغرب ونشرها في كتاب واحد. استيقظ الحاكي، متوجسا من لسعات الذكريات الجميلة، ففطن صعوبة تنفيذ وعده له، ومعاودة الدخول إلى بيته في مدينة شفشاون. استفاق من نومه، وكانت المفاجأة غريبة "رن الهاتف وتحققت الرؤية. لقد جمع قدامى طلبته مقالاته التي كتبها بالإنكليزية عن المغرب، وترجموها إلى العربية بقصد نشرها في كتابٍ واحدٍ إكرامًا لذكراه، وطلبوا منه مساعدتهم في مراجعة الترجمة". لقد عبرت مواقف السارد، كمغترب ولد في العواصف وتربى على قوة هبوب الرياح، أن المحن التي لا تقتل تقوي. فإذا كان العصفور يحتاج إلى عش، فإن الأسد يحتاج إلى غابة، والمرء إلى صديق. فما بعد سيدي محمد، من المؤكد أن القيمة السامية للسارد ستمكنه من إيجاد صديق مماثل. للقدر عدالة، وكل شيء مقدر لليوم المناسب.
كانت علاقتهما علاقة مودة صادقة، وثقة ومحبة وإخلاص وعطف، ومنفعة متبادلة وفضيلة واستئمان وأمان. قربهما من بعضهما أضاف لحياتهما نكهة جميلة. تفاعلا بصدق بأفكارهما وأذواقهما ومزاجهما واهتماماتهما. لقد تشاركا الأفراح وصدق النية والإخاء والنصح والمودة والأحزان والألم والمشاكل والضيق والشدة.
لقد عبر النص ببلاغة ناذرة وبأسلوب سلس كيف تبادلا الدعم في الضراء قبل السراء، والحماية أثناء الحضور والغياب، والتستر على الهفوات والأخطاء المصحوب بالنصح والمعاتبة اللطيفة. تبادلا الرضا بدون مجاملة. سيدي محمد كان لا يدل إلا على الخير، كريم في عطفه وحبه، ودائم المساعدة والدعم لصديقه بدون مصلحة مادية أو معنوية. لم يتقاعس يوما في منحه الوقت والجهد الكافيين متى احتاج إليهما. كان مؤنسا ولطيفا، يهزم الوحدة والغم، وينشط التمتع بالهوايات والاهتمامات المشتركة. لا يتردد في تخفيف أو إزالة الشدة والمحنة والضيق عن صديقه. عفيف في كلامه، ولا ينبعث من محياه إلا القبول والاحترام المتبادل. يمقت الغيبة والنميمة والعجرفة والتعالي والكلام الساقط.
إن تمتين الصداقة والتعاون والتضامن بين الكتاب والمؤلفين والعلماء في مختلف الشعب العلمية والأدبية والفنية والتقنية يبقى الرهان المطلوب في عالمنا العربي الإسلامي، الرهان الصعب واليسير في نفس الوقت. لقد شهد التاريخ الدور الريادي للصداقة في تسريع تنوير الثقافات الشعبية، وفي ارتقاء الفعل السياسي والثقافي الديمقراطي.
إن الوضعية الحساسة التي تعيشها المنطقة العربية والمغاربية تستدعي الاقتداء بصفاء صداقة السارد بسيدي محمد. فما أحوجنا إلى علاقات صداقة قوية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول، والعمل سويا لإحياء القيم الحضارية بإرادة وإصرار وحكمة (المروءة، العشرة، المؤاخاة، الألفة، الرعاية، الوفاء، المساعدة، التضحية، المواساة، الجود، الكرم،...).
وفي الختام لن نجد أحسن مما انتقيته من مقولات وأشعار من كتاب "الصداقة والصديق" لأديب الفلاسفة أبو حيان التوحيدي للتعبير عن أمل تمتين علاقات الصداقة والجوار بين الأفراد والجماعات والشعوب في عالمنا العربي:
- قيل لأعرابي: من أكرم الناس عشرة؟ قال: من إن قرب منح، وإن بعد مدح، وإن ظلم صفح، وإن ضويق فسح، فمن ظفر به فقد أفلح ونجح.
- كتب آخر إلى صديق له: مثلي هفا، ومثلك عفا، فأجابه: مثلك اعتذر، ومثلي اغتفر.
- قال العتابي لصاحب له: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة، كامل المروءة، وإذا غبت خلفك، وإذا حضرت كنفك، وإذا نكرت عرفك، وإذا جفوت لاطفك، وإذا بررت كافأك، وإذا لقي صديقك استزاده لك، وإن لقي عدوك كف عنك غرب العادية، وإذا رأيته ابتهجت، وإذا باثثته استرحت.
- وقال الخليل بن أحمد: الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال.
- قال فيلسوف: من عاشر الإخوان بالمكر كافأوه بالغدر.
- قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: حافظ على الصديق ولو في الحريق.
- قال المأمون:
إن أخا الهيجاء من يسعى معك *** ومن يضر نفسه لينفعك
ومن إذا صرف زمان صدعك ***بدد شمل نفسه ليجمعك.
القصة الكاملة للدكتور علي القاسمي : النداء
عندما توفِّيَ صديقي سيدي محمَّد، أحسستُ بالوحدة تحاصرني من جميع الجهات، ولم يَعُد لي مهربٌ منها. فقد كنتُ، قبل وفاته، كلّما ضاقت نفسي وشعرت بالغربة تهبط على روحي مثل غيمة سوداء، أسرعتُ إلى شقَّته دون موعدٍ سابق، فكان يفتح لي الباب مرحِّبًا باسمًا مسرورًا، ويُكثِر من الترحاب بي، ويسألني عن أحوالي. ثُمَّ يتّجه إلى المطبخ، فيضع إبريق الماء على الموقد لإعداد الشاي، ويملأ صحنًا بقطع الحلوى المغربية: كعب الغزال، المحنّشة، القطايف، ثمَُّ ننقل كلَّ شيءٍ من المطبخ إلى غرفةِ الجلوس، ونشرع بالحديث وتناول كؤوس الشاي بالنعناع مع الحلوى. وبعد ساعةٍ من حديثه الحلو المليء بالنوادر والطرائف، أشعر بالارتياح، كما لو كان ذلك الإحباط الذي أثقل روحي قد انزاح شيئًا فشيئًا، حتّى غدا قلبي خفيفًا يستطيع مسابقة الريح. فأنهض مستئذِنًا بالانصراف لأعود إلى أشغالي. وهنا تثور ثائرته، لأنّني لم أبقَ معه ما فيه الكفاية، أو كما كان يقول محتجًّا: " ما سلّم حتّى ودّعا."
أمّا اليوم، وبعد أنْ غيّبه الموت، فلا أدري أين اتَّجه، إذا ما داهمني الشعور بالغربة والوحدة، ولا أعرف بِمَن أحتمي. فقد كان سيدي محمد صديقي الوحيد، وملاذي في هذه المدينة. صحيحٌ أنّ لي كثيرًا من المعارف الطيِّبين فيها، ولكنَّني لم أشعر تجاه أيٍّ منهم بما أشعر به من رفع الكلفة مع سيدي محمد. لم أكُن أستطيع أن أُفضي بمكنون قلبي للآخرين، أو أكاشفهم بآلامي وآمالي وما يثقل روحي. أمّا سيدي محمد فقد كنتُ أحسبه واحدًا من أهلي، أطمئن إليه ويطمئن إليّ، وأرتاح إليه كما يرتاح إليّ. وكان التفاهم بيننا تامًّا. لعل ظروفنا المتشابهة وأحوالنا المتماثلة هي التي يسّرت ذلك التواصل بيننا. فقد تربَّينا في عائلتيْن محافظتيْن، وتعلّمنا في مدارس متشابهة، وتخصَّصنا في موضوعاتٍ متقاربة، وزاولنا مهنةً واحدة.
وعندما كنتُ أزوره في المستشفى في الأيام الأخيرة من حياته وهو يصارع ذلك المرض الوبيل بشجاعةٍ نادرة، لم أكُن أدري ما أقوله له، فقد استنفدتُ جميع كلمات الأمل وجميع الأخبار السارّة. وحينما أجده وحده في غرفته، نأخذ في النظر أحدنا إلى الآخر، وتهرب الكلمات من شفتَيّ، وأحسُّ بالدموع تنزُّ من أعماقي إلى جفوني، فأُسرع خارجًا من الغرفة وأنا أنادي: " أين الممرِّضة؟"، لأُخفي دموعي عنه لئلا أزيده حزنًا على حزن. ولعلَّ حزني ذاك كان من قبيل الأنانيّة، فقد كنتُ أتوقع ما سيحلّ بي من وَحدةٍ وغربةٍ بعد رحيله.
ووجدتني ذات مساء أقف عند سريره وشفتاي تتمتمان بآيات من القرآن وتمجّان ملوحة دموعي. وأسلمتُ أمري إلى الله. وعزيّت نفسي قائلاً لا مفرَّ من الموت وكلُّ النّاس وارده. ولكنّني بقيت أشعر بالوحدة، حتّى عندما أكون محاطًا بعشرات الأشخاص.
وبذلت جهدي كي أنساه، فقد مرّ عامٌ كاملٌ على وفاته وصورته ماثلةٌ في عيني، وهيئته شاخصةٌ في قلبي، وصوته ملء أذنيّ. وخشيت أن أُصاب بالاكتئاب، فقد قرأت آنذاك أنَّ الكاتبة اللبنانيَّة مي زيادة قد أُصيبت بالاكتئاب بعد أن توفّي والداها وتوفّي الأديب جبران خليل جبران الذي أحبَّته بالمراسلة. ولهذا ابتعدتُ عن المدينة في عطلة لبضعة أسابيع أمضيتها على شاطئ البحر، لعلّ محيطُه الشاسع يتّسع للأسى الجاثم على روحي، أو لعلّ أمواجه تغسل الحزن الرازح على قلبي. وهناك درّبتُ نفسي على أن أصرف ذهني عن مأساة صديقي سيدي محمد. كنتُ أُغرِق نفسي في التفكير بأشياءَ أُخرى، بمشاريعَ ثقافيةٍ يحتاج الإعداد الذهني لها ساعاتٍ طويلة. وبعد التمرين المتواصل على صرف التفكير إلى المستقبل بدلاً من الماضي، هنّأتُ نفسي على نجاحي في ذلك وعدتُ إلى المدينة.
في تلك الليلة، استطعتُ أن أغمض عينَيّ دون عناء، ودون أن أكابد عذاب السهد الذي كان ينتابني في ذلك الفراش. كنتُ أقرأ في رواية " جارات أبي موسى " للكاتب المغربيّ أحمد التوفيق، وراح النعاس يثقل أجفاني وسقط الكتاب من يدي جانبًا وغفوتُ.
في تلك الليلة ألمّ بي حُلم بهيج. رأيتُ نفسي أسيرُ في مرجٍ أخضرَ واسعٍ، تجري فيه سواقٍٍ عديدة يترقرق فيها الماء جَذِلاً صافيًا، وتنتشر فيه أشجار الحور والزيزفون والصفصاف والسنديان، وفي ظلالها ازدهرت أزهار الورد والقرنفل والقدّاح والياسمين. وراحت العصافير والعنادل وطيورٌ أُخرى تحلّق من شجرة إلى أُخرى، وهي تزقزق وتغرّد. ولاح لي في آخر المرج قصرٌ منيفٌ له قبابٌ خضر، وسورٌ أبيض منخفض، تسلَّقتْ عليه شجيراتُ اللبلاب، وتوسَّطه بابٌ خشبيٌّ أزرقُ موارب.
قصدتُ القصر. اقتربتُ من بابه. ودخلتُ. أذهلني منظر حديقته وطرازها المغربيّ الأندلسيّ، والينابيع المتدفِّقة من صخورها، والنافورات التي تتوسَّطها. ذكّرتني بحديقة "جنة العريف" في قصر الحمراء بغرناطة. واصلتُ السير حتّى بلغتُ بركةً غاية في الحُسن والبهاء، وإلى طاولةٍ أُقيمت على حافتها، كان يجلس ـ لشدَّ دهشتي وفرحتي في آن ـ صديقي سيدي محمد.
ما إن رآني حتّى نهض هاشًا باشًا كعادته. تعانقنا فرحيْن باللقاء. راح يسألني عن أحوالي. طمأنته. ثُمَّ سألته ببلاهة ما إذا كان يحتاج لأمرٍ أقضيه له هناك. تردّد لحظة، ثمَّ قال: نعم أرجوكَ أن تجمع مقالاتي المُتفرِّقة التي كتبتُها عن المغرب، وتنشرها في كتابٍ واحد. وعدتُه بحماسة أنّني سأفعل، قائلاً: اطمئنْ، أعِدكَ بذلك. وكان من حماستي أنّني ضربتُ بقبضة يدي على الطاولة التي أمامه مؤكِّدًا وعدي، فأخذ فنجان الشاي الذي أمامه يرتجف على الطاولة مُحدثًا جلجلةً مثل جرس.
كان جرس الهاتف يرّن في غرفة الجلوس. استيقظتُ. اتجهتُ إلى مكان الهاتف والحُلم واضح أمام عيني. وأخذتُ ألوم نفسي قائلاً: كيف أعِدُ صديقي سيدي محمد بِجمع مقالاته وهي متفرِّقة في مكتبته الشخصيّة في دارته في شفشاون، وأنا أتحاشى دخول تلك الدارة منذ وفاته، ولا أظنّني أطيق رؤيتها مرَّةً ثانية. سيقتلني الحزن فيها.
رفعت سماعة الهاتف قائلاً :
ـ نعم؟
ـ أنتَ لا تعرفني، يا سيدي، ولكنّني أعرفك. اسمي الخرشاف. قمتُ وبعض زملائي من قدامى طلاب الأستاذ سيدي محمد بجمع مقالاته التي كتبها بالإنكليزية عن المغرب، وترجمناها إلى العربية بقصد نشرها في كتابٍ واحدٍ إكرامًا لذكراه. ونحن نرجوك مساعدتنا في مراجعة الترجمة.
ـ سأفعل بكلِّ سرور. شكرًا، شكرًا لكم.
تقييم النص
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا
التعليقات
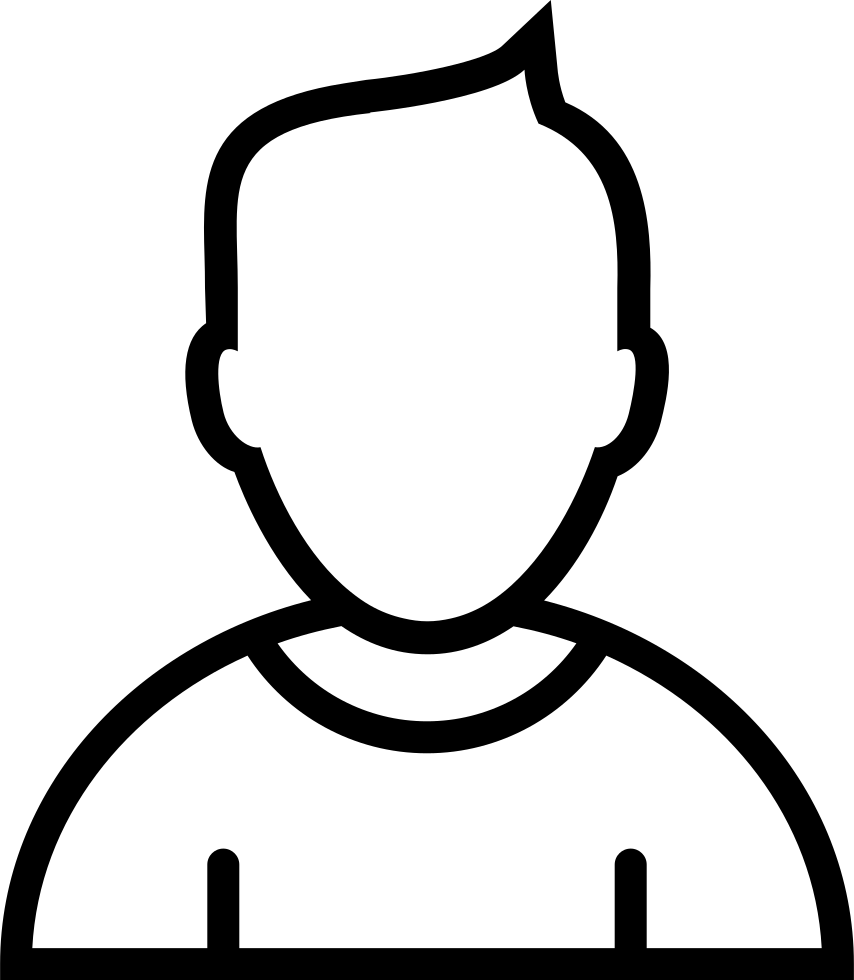
علي القاسمي
10-04-2022 04:06
عزيزي الكاتب الأديب الأستاذ الحسين بوخرطة حفظه الله ورعاه،
أشكرك على تعليقك الكريم على قصتي " النداء" الذي لم أطلع عليه إلا اليوم في آفاق معرفية الغراء. فعذراً.
هذه من القصص التي أعتز بها شخصياً، لأنها واقعية تماماً، ولم تأخذ مني وقتاً في كتابتها، فقد كتبتها مباشرة بعد الحلم والمكالمة الهاتفية.
وقد كانت الصداقة الأخوية الروحية التي تربطني بالمرحوم الأستاذ محمد أبو طالب عميقة وثيقة لدرجة أننا كنا نتواصل عن بُعد بلا هاتف أو حاسوب. فعندما أود رأيته أجده يطرق الباب بعد أقل من نصف ساعة. وعندما يحتاجني في أمر يجدني بين يديه .
أكرر شكر ي ومودتي واحترامي.
أخوك: علي القاسمي
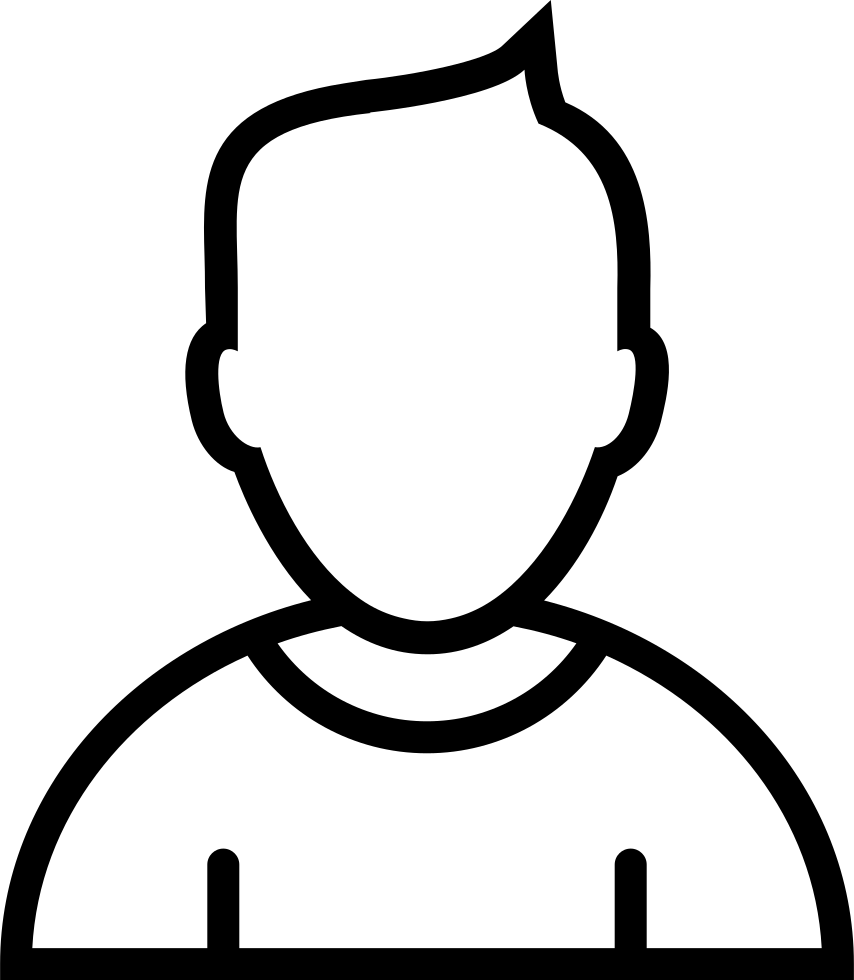
علي القاسمي
10-04-2022 04:06
عزيزي الكاتب الأديب الأستاذ الحسين بوخرطة حفظه الله ورعاه،
أشكرك على تعليقك الكريم على قصتي " النداء" الذي لم أطلع عليه إلا اليوم في آفاق معرفية الغراء. فعذراً.
هذه من القصص التي أعتز بها شخصياً، لأنها واقعية تماماً، ولم تأخذ مني وقتاً في كتابتها، فقد كتبتها مباشرة بعد الحلم والمكالمة الهاتفية.
وقد كانت الصداقة الأخوية الروحية التي تربطني بالمرحوم الأستاذ محمد أبو طالب عميقة وثيقة لدرجة أننا كنا نتواصل عن بُعد بلا هاتف أو حاسوب. فعندما أود رأيته أجده يطرق الباب بعد أقل من نصف ساعة. وعندما يحتاجني في أمر يجدني بين يديه .
أكرر شكر ي ومودتي واحترامي.
أخوك: علي القاسمي
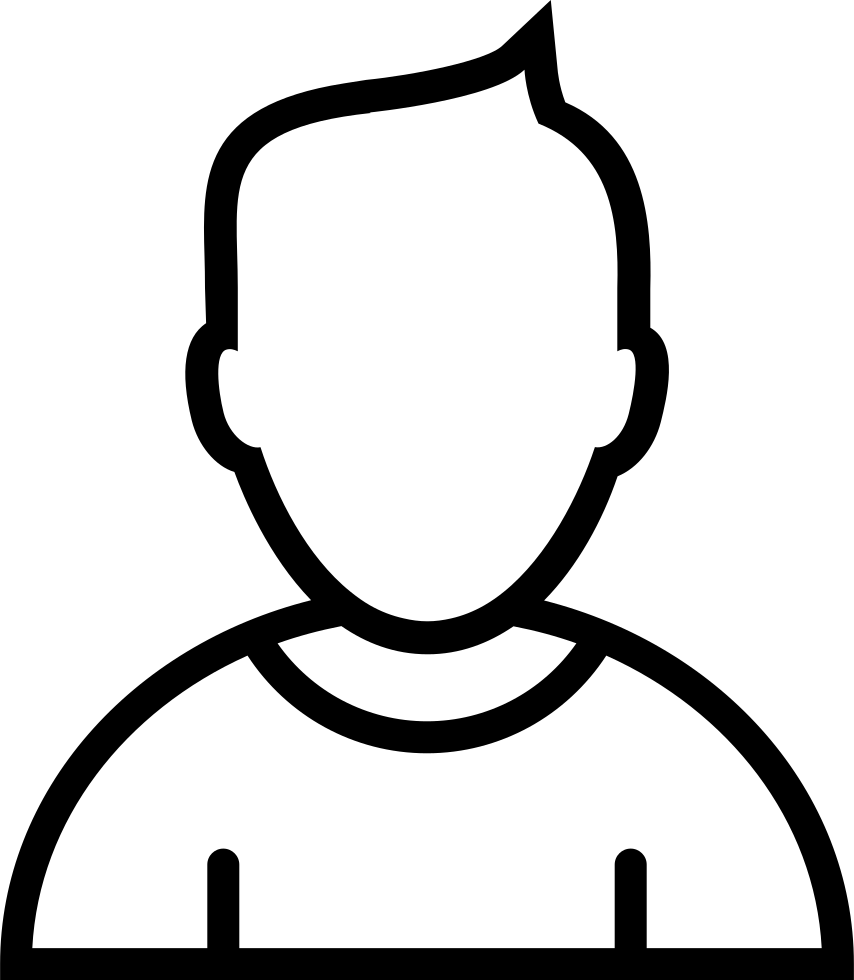
علي القاسمي
10-04-2022 04:06
عزيزي الكاتب الأديب الأستاذ الحسين بوخرطة حفظه الله ورعاه،
أشكرك على تعليقك الكريم على قصتي " النداء" الذي لم أطلع عليه إلا اليوم في آفاق معرفية الغراء. فعذراً.
هذه من القصص التي أعتز بها شخصياً، لأنها واقعية تماماً، ولم تأخذ مني وقتاً في كتابتها، فقد كتبتها مباشرة بعد الحلم والمكالمة الهاتفية.
وقد كانت الصداقة الأخوية الروحية التي تربطني بالمرحوم الأستاذ محمد أبو طالب عميقة وثيقة لدرجة أننا كنا نتواصل عن بُعد بلا هاتف أو حاسوب. فعندما أود رأيته أجده يطرق الباب بعد أقل من نصف ساعة. وعندما يحتاجني في أمر يجدني بين يديه .
أكرر شكر ي ومودتي واحترامي.
أخوك: علي القاسمي

لا يوجد اقتباسات