الأعمال القصصية/ من مجموعة رسالة إلى حبيبتي/ القصة رقم 3 (وفاء)
كان لونها الناصع البياض يعانق اللون الفضي لماء النهر، فيتداخل معه ويمتزج به ويذوب فيه، حتّى يغدوان لونًا واحدًا متموجًا متلألئًا، بفعل حركة النهر ونور القمر المطلِّ من الأعالي. وينعكس أَلَقُ الضوء الذي يلامس جسمها الممتلئ، على عينَيَّ، وينفذ منهما إلى أعماقي، فينبعث بي إحساسٌ لذيذٌ بالنشوة والارتياح. تمدُّ عنُقُها الطويل المقوّس كالخنجر، إلى الأمام، وتغمره في الماء هنيهة، وهي منسابة على سطح النهر كزورقٍ ورقيٍّ أنيق، ثمَّ تستلُّه وتنفض رأسها، فتتطاير القطرات منه؛ ويلامس وجهي بعض الرذاذ البارد، فأشعر بانتعاشٍ يسري في أوصالي، وأُطلق ضحكاتي الطفولية وصرخاتي المرحة. تفرد جناحيْها مشرعيْن، وتحرِّك ذيلها بسرعة، وبخفقاتٍ متناسقةٍ متلاحقةٍ من الجناحيْن، تندفع محلقةً على بساط الماء لمسافة بضعة أمتار، وهي تبعث بصيحاتٍ حادةٍ جذلى تمزق سكون الليل، ثمَّ ترجع عائمةً صوبي، فأستقبلها باسمًا فرِحًا بعودتها. وتقترب مني، وأنا على حافة النهر، حتّى تلامس أصابعي ظهرها الناعم وأُمسِّد ريشها للحظات، فـتـتجه عائمة إلى وسط المجرى لتواصل سباحتها اليومية.
شغفتُ بتلك البطَّة منذ اليوم الأوَّل الذي حملها فيه والدي هديةً لي بعد نجاحي في السنة الرابعة الابتدائية. كانت صغيرة أوَّل الأمر ثمَّ أخذت تكبر بسرعة، وتكبر معها الأُلفة والمودَّة بيننا حتّى أضحت صديقتي الأثيرة ودُميتي المفضَّلة. اقترحت عليّ أُختي أن نعطيها اسمًا، فاخترتُ لها اسم (وفاء)، ودأبتُ على مناداتها به حتّى تعوَّدت عليه، وأخذتْ تلتفت إليّ عند سماعه أو تجيب ب (واق) وكأنَّها تقول (نعم). لا أدري لماذا انتقيتُ لها ذلك الاسم؛ لعلَّه كان سهل النطق، أو تيمُّنا باسم بنت الجيران الصغيرة التي كانت ترتدي فستانًا من الدانتيل الأبيض، أو لأن أُمِّي البدوية كانت تحضنني وأختي في حِجرها كلَّ ليلة، وتروي لنا حكايات عن وفاءِ البدو: وفاء الصديق للصديق، وفاء الزوج للزوج، وفاء البدويِّ بالعهد الذي يقطعه على نفسه، أو لأنَّ أبي كان يحفّظني تلك الأيام قصيدة للشاعر العربي الجاهلي السموأل الذي اشتهر بالوفاء والذي لا تبعد قريتنا كثيرًا عن أطلال دياره. أعترفُ أَنَّني على الرغم من عدم استيعابي الكامل لمفهوم الوفاء يومذاك، فقد استهواني الاسم وخلعته على بطَّتي الحبيبة.
كانت بطَّتي تشاركني في طعامي، فعندما كنت أجلس الى المائدة مع أبي وأمي وأختي، كانت وفاء تقف بجانبي حيث أضع لها شيئا من السلطة فتلتهمها بسرعة خاطفة، وحينما كنت أراجع دروسي كانت تقف قبالتي فأرمي لها بعض الحبوب، وفي مثل لمح البصر تلتقطها حبّةً حبَّةً بمنقارها العريض. وكانت ترافقني معظم الوقت في أرجاء المنزل، تتبعني من غرفةٍ إلى أُخرى، ومن الفناء إلى الحديقة، ومن هناك إلى السطح. وانتهى بها الأمر إلى النوم بالقرب مني على السرير، وكانت يداي تمسّدان ريشها الناعم، وأنا أستمع إلى حكايات أُمّي حتّى تستسلِم جفوني لسلطان النوم. وعندما أذهب إلى المدرسة صباحًا، تمشي معي حتّى باب المنزل؛ وعند عودتي من المدرسة، أَجدها واقفةً عند باب المنزل، وهي تحرِّك رأسها وذيلها باستمرار؛ وحالما تراني تُطلِق صيحاتٍ جذلى. وقد أخبرتني أُمّي أَنَّه حين يقترب موعد عودتي من المدرسة، تتَّجه بطتي نحو باب المنزل، وتبقى هناك حتّى أدخل. وقد راودتني فكرة اصطحابها إلى المدرسة، ولكنَّني خشيتُ أن يطردها المعلم من الصَّفِّ أو يستهزئ بي زملائي التلاميذ.
كانت دارنا في أطراف القرية لا تبعد كثيرًا عن النهر، إذ لا تفصلها عنه سوى مزرعةٍ للخضراوات لا تحول نباتاتها دون رؤية النهر من شرفات منزلنا. وكان من عادة والدي أن يخرج كلَّ مساء بعد صلاة العِشاء، ليتمشّى بعض الوقت، ثمَّ يتوقَّف على ضفة النهر قبالة دارنا، ليتسلّى بصيد السمك. كان يضع الطُّعم في الصنّارة، ثمَّ يُلقي بها بعيدًا في الماء، وبعد وقتٍ يقصر أو يطول، يهتزُّ مقبض الصنّارة بيده، فيبتسم إدراكًا منه أنَّ سمكةً ما قد علقتْ بصنّارته، فيلفُّ الخيط على الحامل حتّى تخرج السمكة من الماء، وهي تضطرب وتهتزُّ بشدَّة، يقبضها بيده، يتأمَّلُها قليلًا، يخلِّصها من الصنّارة، ويعيدها برفقٍ الى الماء. وكان من حينٍ لآخر، يصطحبني معه في نزهته المسائية تلك. ومنذ أن حازت البطَّة على عضويَّة العائلة، صرتُ أرافق والدي كلَّ مساء في تلك النزهة، والبطَّة في إثري ، بطبيعة الحال. وفيما كان والدي يصطاد السمك ويتحدَّث إليّ، كانت البطَّة تسبح بالقرب منّا في النهر، غاديةً رائحةً. وعندما يحين موعد العودة إلى المنزل، تكفي مناداتها باسمها لتقفل راجعةً نحونا بسرعة، ثمَّ تمشي متبخترةً وراءنا إلى المنزل.
في مساء ذلك اليوم، كان والدي مسافرًا إلى مدينةٍ أُخرى، في شأنٍ منشؤون تجارته. وبعد العشاء، استأذنتُ والدتي لاصطحاب بطَّتي إلى النهر لتسبح. قالت أُمّي وهي متردِّدة:"إنَّ أباك غائب، أليسَ من الأفضل الانتظار حتّى يعود صباح الغد؟" أجبت محتجًّا: "ولكنَّني لم أعد طفلاً، لقد أصبحتُ رجلاً. يمكنكِ الاعتماد عليّ، يا أُمّاه." ثمَّ انفلتُ خارجًا والبطَّة ورائي.
وسرعان ما وصلنا إلى النهر، واندسَّت البطَّة في مائه، وكنتُ والقمر نشاهدها تعوم طافيةً على الماء، وتغطس فيه، ثمَّ تبرز لتنتفض هنيهة، ثمَّ تغطس ثانية، وأنا أواصل توجيه الكلام إليها، ومداعبتها بأطراف أناملي، والقمر يستمر في إرسال أشعته إليها، ويغمرها بنوره.
وبينما كنّا على تلك الحال، ظهرَ في أعلى النهر سِربٌ من البط البري، تتقدَّمه بطَّةٌ كبيرةٌ قاتمةُ اللونِ كالبجعة السوداء، وهو متّجه جنوبًا مع مجرى النهر، ويطلق أفراده صيحاتٍ متلاحقةً متقطِّعةً غيرَ متناسقة. توقَّفتْ بطتي عن اللعب، ولوت رقبتها الطويلة نحو سرب البطّ. وعندما صار السرب إزاءنا في وسط النهر، رأيتُ بطَّتي تتحركُ نحوه ببطءٍ ثمَّ بسرعةٍ متزايدةٍ، وهي تبعث بصيحاتٍ مماثلة، فتنضمُّ إلى بقية البطِّ، وتنساب معه في وسط الماء منحدرة مع المجرى، وتأخذ في الابتعاد شيئًا فشيئًا. ناديت: "وفاء"، وأنا أتقدَّم خطوةً أو خطوتيْن على جرف النهر، فلم تلتفتْ إليّ. وكرّرت النداء بأعلى صوتي: "وفاء، وفاء، وفـ…" فلم تعرني انتباهًا، بل لمحتُ عنقها الطويل يميل إلى البطّات المجاورات عدّة مرّات. وراح السرب يبتعد أكثر فأكثر حتّى قارب منحنى النهر، وأنا أتطلع إلى القمر في الأعالي بين الفينة والفينة وكأنَّني استنجد به. وبعد لحظاتٍ، اختفى سرب البطِّ وراء المنحنى، ولم أَعُدْ أُبصر شيئًا في وسط المجرى، سوى انعكاس نور القمر على صفحة الماء المتموِّجة.
وقلتُ في نفسي ستعود إليّ، إِنّها تعرف الطريق تمامًا، إنَّها متمرِّسة في السباحة في النهر. سأنتظرها، سأظلُّ في مكاني. وأَحسستُ ببرودة الماء في قدميّ، فتذكَّرتُ حكايةً روتها لي أُمّي ذات ليلة. قالتْ: "إنَّ ليلى التقتْ قيسًا في صباح يومٍ ربيعيٍّ، وهي تحمل جرَّةَ ماءٍ على رأسها، طلبتْ منه أن ينتظرها حتّى توصل الماءِ إلى أهلها وتعود إليه. وعندما شارفتْ مضارب أهلها، ألفتهم يرحلون بِجِمالهم، وحملها إخوتها ووضعوها في الهودج، ولم يعُد بإمكانها أن ترجع إلى حبيبها لتخبره. وظلَّ قيس ينتظر وينتظر، حتى أعشبتِ الأرض من بين أصابع قدميه." لا شكَّ في أنَّه شعر ببرودةٍ في قدميْه، هو الآخر. لقد انتظر طويلاً، وأنا سأنتظر بطَّتي، فهي لا بُدَّ أن تعود إليّ.
وبقيتُ في مكاني منتظرا مصطبرا حتى وافتني أُمِّي وأُختي على ضفة النهر، لتلفياني والدموع في عينيّ، وأخبرتُهما منتحبًا بما جرى، ولبثتُ أردِّد " لماذا؟ لماذا؟ لماذا تخلَّت عني؟" وهما تقودانني إلى المنزل. وقالتْ أُمّي، وهي تقبِّلني، وتضمُّني إليها، وتمسح الدموع من خدّي: " لعلَّ البطُّ ومجرى النهر جرفاها من غيرِ إرادة منها، ولعلَّها تعود إلينا إنْ استطاعت لذلك سبيلا." وأَطبق الصمتُ شفتَي أُختي، ولكنُّني كنتُ ألمح نظراتِ الأسى والمؤاساة في عينيْها.
ونمتُ تلك الليلة على وسادتي المبتلَّة بِعَبراتي. وعندما استيقظت ضحى الغد، لفتَ نظري رجلان يحفران شيئًا في فِـناء الدار الواسع. وذهبتُ لأقبِّل يدَي والدتي ووالدي كعادتي كلَّ صباح، فوجدتُ أمامهما بطَّتيْن صغيرتيْن. وقال لي والدي: لقد جلبتُ لكَ معي هاتيْن البطتيْن هديَّةً، وسنبني حوض سباحة في حوش المنزل لتعوما فيه دون أن تضطرَّ إلى اصطحابهما إلى النهر.". ولكنني أجبتُ بصوتٍ متهدج، وأنا مطأطئ الرأس: " أريد بطَّتي، وفاء"
تقييم النص
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا
التعليقات
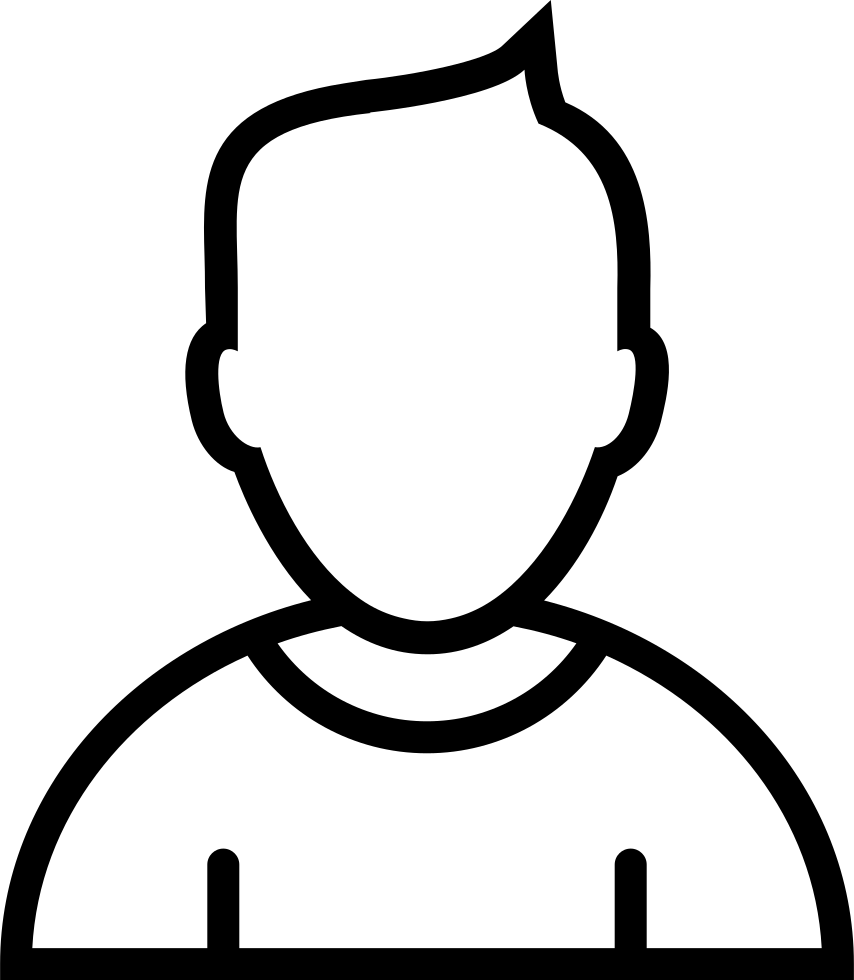
الحسين بوخرطة
30-06-2021 06:12
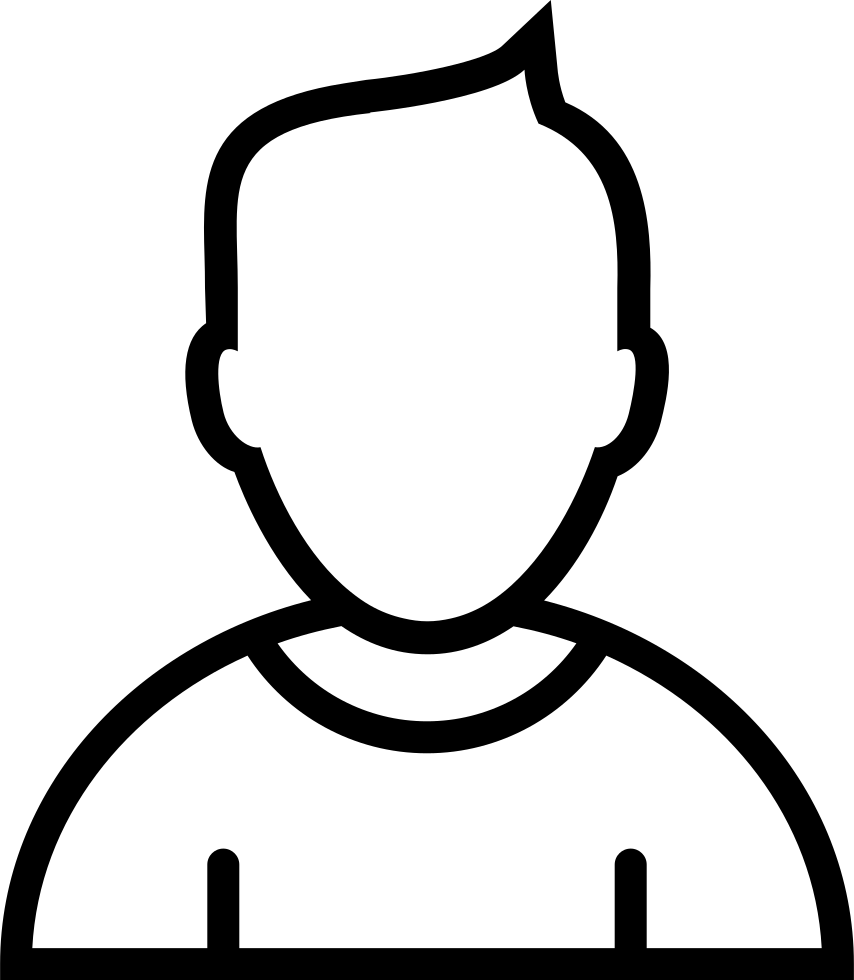
علي القاسمي
09-07-2021 07:08





لا يوجد اقتباسات