وداعاً، يا أُمّي! / فصلة من رواية " مرافئ الحب السبعة"
"إنَ النوم العادي يفعل ما تفعل، ويعطي ما تعطي، فلا تفخر ولا تتبختر، وسيأتي يومٌ تموت فيه أنتَ، أيّها الموت!"
الشاعر الإنكليزي جون دُون
بعد أن تناول سليم عشاءَه في مطعم الطلبة بالجامعة تلك الليلة، ذهب إلى المكتبة المركزيّة التي تحتلُّ برج الجامعة. استقلَّ المصعد إلى الطابق الثاني عشر حيث توجد مقصورته الصغيرة. فتح حقيبته، وأخرج كُتُبه منها، ووضعها على رفِّ المكتب أمامه. نظر إلى يمينه عبر النافذة المطلَّة على مدينة أوستن. تراءت له مياه نهر كولرادو اللامعة بفعل الأضواء المنعكسة عليها.
حدَّقتُ في الأضواء المتلألئة في فضاء المدينة. وفجأةً يأسر نظري ضوءٌ واحدٌ من تلك الأضواء الكثيرة. أشعر بأنَّ النور القادم من ذلك الضوء يمتدُّ إلى عينَيّ، ينفذ فيهما إلى أعماق ذاتي، فينفتح أمام بصيرتي؛ مشهدٌ يثير استغرابي. إنّه منظر قريتي على نهر الفرات الأوسط، يقترب المنظر مني بسرعة حتّى تتبيّن لي دارنا، تنفتح باب الدار فأرى حشداً كبيراً من الناس، رجالاً ونساء، وفي وسطهم أربعة من أشقائي الكبار يحملون نعشاً، وهم يردِّدون: " لا إله إلا الله، الله أكبر "، ينزاح الغطاء عن النعش فتبدو لي أُمّي مُسَجاةً في التابوت. أشحتُ بوجهي عن المشهد. أسرعتُ إلى المغسلة القريبة، غسلتُ وجهي بالماء البارد، تعوَّذتُ بالله من الشيطان.
وراح سليم يتساءَل في ذاتِ نفسه عمّا إذا كان ما رآه هو مجرَّد كابوسٍ من كوابيس اليقظة، أم أنَّه تخاطرٌ حقيقيٌّ مع أهله. واستبعد هذا النوع من التخاطر بعد أن ضعفت القدرة عليه لدى الإنسان بسبب اعتماده على وسائل الاتِّصال الحديثة، وذلك طبقاً للمبدأ المعروف في علمِ الأحياء: " كلُّ عضو يُستعمَل ينمو ويكبُر، وكلُّ عضو يُهمَل يضعف ويضمُر". لعلّ حنينه الشديد فعَّل لديه هذه القدرة الذاتيَّة على التواصل.
عاد سليم إلى شقَّته الصغيرة مبكِّراً تلك الليلة. قبل أن يولج المفتاح بالباب، فتح صندوق البريد المثبت على الحائط بجانب الباب، فوجد برقيةً من والده. دخل الشقَّة، وألقى بنفسه على سريره، وفضَّ ظرف البرقيّة ليقرأها:
" ولدي العزيز سليم حفظه الله ورعاه،
بعد الدعاءِ لكَ بالتوفيق والنجاح، وتقبيلِ ناظرَيك ووجنتَيك، فإنَّه يحزنني ويحزُّ في نفسي أن أنعى إليك أمَّكَ العزيزة التي انتقلت إلى بارئها. كانت أمنيتها الوحيدة هي أن تراك قبل أن تودَّعنا، وفي ذلك الصباح أخبرتنا أنّها رأتكَ في حُلمٍ شارد، ثمَّ أسلمت الروحَ قريرةَ العين. عزاؤنا واحد. أسأل المولى أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويُلهمكَ وإيانا الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون."
كانت تلك الكلمات القليلة في البرقية بمثابةِ زوبعةٍ عصفتْ بخيمتي الواهية، اقتلعتْ دثاري الوحيد من طيفِ أُمِّي الدافئ الذي كنتُ أحمله معي من منفىً إلى منفى، وأتدثَّر به في ليالي الغربة الباردة عندما يشتدُّ زمهريرُ الفراق. زوبعةٌ أبقتني عارياً في صقيع الوحدة.
هذه الكلمات القليلة كانت كافية لتجعل سليم ينهض من فراشه، يجلس على حافته، يضع يديه على وجهه، تترقرق الدموع في عينَيه، تتوالى الرؤى في مُخيِّلته. رأى أُمَّه وهي تحتضنه طفلاً بين ذراعيها، تضمُّه إلى صدرها، تغمره بالقُبل، تداعبه، تقصُّ عليه حكاياتها البدويَّة، تروي له كيف أنَّه ذاتَ يومٍ كان رضيعاً يحبو وقد وضعته في فراشه في حديقة المنزل، ليلعب بالدُّمى وذهبتْ إلى التنور الكائن في الطرف الآخر من الحديقة لتخبز الخبز وتناغيه من بعيد، لكنّها بعد هُنيهةٍ سمعتْ صوتَ ارتطامٍ عالٍ كصوت الطبل، فالتفتتْ إلى فراشِه فلم تجده، ونظرتْ إلى الدلو على حافة البئر فلم تجده، فجَرَتْ مسرعة إلى البئر وقفزتْ فيها، ولامست رجلها اليمنى جسده اللدن فرفعتْه بكلتا يدَيها إلى الأعلى؛ وكان ماءُ البئر يغمرها حتّى رقبتها، وأخذت تنادي فأنجدها أحد الجيران من أقاربها. ولهذا كان كثيراً ما يقول إنَّ أُمَّه ولدته مرَّتَين. هذه المرأة التي وهبت الحياة لاثني عشر ولداً، والتي كانت دائماً محاطةً بأطفالها وجاراتها، ضاحكةً تنبض بالنشاط، وفي عينَيها الواسعتَين ترقص الحياة، أمستِ اليوم هامدةً وحيدةً في جدثٍ مُظلمٍ لا عودة منه. وتساءل في نفسه إذا ما رجع غداً إلى بلدته وطرق الباب، ألا تفتح الباب له بنفسها، كما عوَّدته؟ كانت تعرفه من طرقه: طرقةٌ واحدة، طرقتان متلاحقتان، ثم ّطرقةٌ أخيرة. فتُسرِع بنفسها ولا ينافسها أحد من إخوته أو أخواته.
في تلكَ اللحظة هبَّتْ روحي تسابق السحب في اتِّجاه ملاعبِ الطفولة ومرابض الصبا؛ ووجدتني أذرف عندها دموع الحرقة والضيم، أُسمِعها كلماتِ العتاب، أشكو عندها ألمَ الفراق، أقول لها إنَّ أدغال غربتي سدَّتْ مساربَ الروح وأوصدتْ شبابيكَ القلب والعينَين، وتأصَّلتْ مرارتُها في جذور الروح. في تلك اللحظة، نفذت رائحة دارنا إلى رئتَيَّ. كانت لدارنا نكهةٌ خاصَّةٌ هي خلطة عجيبة من رائحة التوابل الشرقية وأريج الورد الجوري والقداح والفلّ والياسمين، عندما يهب النسيم من النهر. في تلك اللحظة رأيتُني صغيراً أبكي عند مُنحنى النهر، ويتسلَّمني الجسر، يسلّمني إلى الضفة الأخرى، وأسير في دروب القرية القديمة، وألج بابَ منزلنا، وأتَّجه إلى سرير أُمّي وأنام في حضنها، فتضمّني بكلتا يدَيها، وتقبِّل وجنتي، وتمسِّد شعري. كم كان لذيذاً النوم في حضنك يا أُمّاه!
قام سليم من فراشه، واتَّجه إلى رفوفِ الكُتُب في الشقَّة، وتناول دفترَ الصور؛ فتحه، طالعته صورةٌ تجمع والديه، حدّق فيها طويلاً فتمثَّلتْ له أمُّه يكلّلها كفنٌ أبيضُ، وهي مسجّاةٌ في تابوتٍ يحمله إخوته على أكتافهم إلى المقبرة، يمسك أحد أولادها معولاً، يحفر جدثاً، ويشق فيه لحداً، ثم يتناول الجثمان من أخوته بيدين مرتعشتَين وشفتَين مطبقتَين، ويوسده التراب، ثمَّ يهيلون عليه الرمل ويبني فوق الرمس شاهداً، ويودعون عشرين عاماً أو أكثر من الأُمومة الرؤوم. وهكذا ترحل أمُّه من شاطئِ الحياة إلى مرفأِ العدم عبر بحر الظلمات ذي الاتِّجاه الوحيد.
تساءلتُ في نفسي هل يستطيع أستاذي الدكتور أرتشبولد أي هيل أن يفسِّر لي رمزَ الموت ودلالته كما يشرح رموز القصص ودلالاتها، أم أنَّ قصة الموت تختلف عن جميع قصصِ الحياة. لا أدري لماذا تذكّرتُ في تلك اللحظة رواية " قصر أُمّي " للكاتب الفرنسي مارسول بانيول الذي تأسَّف كثيراً، لأنَّ أُمَّه لم تشهد نجاحاته اللاحقة في الحياة، ولم تهنأ بالمنزل الجميل الذي كانت تتمناه في حياتها، والذي اشتراه ابنها بعد وفاتها. لكنَّي قلتُ في نفسي: " أَيَّةُ نجاحاتٍ ستشاهدها أُمّي لو ظلَّت على قيد الحياة؟ لم أحصد في مزرعةِ الغربة سوى الخيبة. سألحق بكِ، يا أمّي قريباً، حتّى إذا أخطأني الموتُ سنةً أو سنتَين... حتّى إذا تأجّل رحيلي ليوم ٍأو يومَين، فقد سئمتُ الانتظار."
كان في زاويةٍ من زوايا نفسه القاتمة بالفراق، ثمَّةَ كوَّةٌ ينسلُّ منها بصيصُ أملٍ في العودة إلى وطنه يوماً ما، ليفرح بلقاءِ أمِّه وأبيه وإخوته. أمّا اليوم فإنَّ فظاعة المأساة جعلته يشعر بعبثِ الحياة المذهل، وتفاهةِ الآمال. والدمعة التي انحدرت على خدِّه، رغم ما تعبِّر عنه من هولِ المصيبة، فإنّها مجرَّد عبثٍ آخر لا يغيِّر من قسوةِ الحياة وهشاشتها في آنٍ واحد. لن يرى أُمَّه بعد اليوم، ولن يفيده طيفها وهو يمرُّ بخاطره، أو خيالها وهو يخطر في البراري. السراب لا ماءَ فيه لظمآن.
إنَّه الموت يحلُّ بوادينا مرَّةً أُخرى. ما أشدَّ جزعي اليوم. سربلني صمتٌ أسود. لم أدرِ ما أقول. وهل ينفع قول بعد أن فعل الموت فعلته. قمتُ متثاقلاً من غير وعي كمن يمشي في نومه. توجهتُ إلى حقيبتي، فتحتها ببطء، أخرجتُ شال أُمّي الذي أخذتُه معي في ذلك الفجر الشاحب الذي غادرتُ فيه قريتي، وصرَّةَ التراب التي حملتُها معي. وغرفتُ بكفي حفنةً من التراب، قرَّبتُها من أنفي، شممتُ بها رائحةَ أرضنا ورائحةَ أُمّي معاً، أحسستُ ببرودتها. وتناولتُ شالَ أُمّي، عصبتُ به رأسي ووضعت طرفه على وجهي ثم غطّيتُ عيني به، فتكشَّفتْ أمام عيني أمّي وهي تحتضر وتهمس بصوتٍ واهن: " سليم، سليم". لا بدَّ أنّها كانت تتمنّى أن أكون إلى جانبها في تلك اللحظة، أمسك يدَيها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة.
هل تتوسدين يا أُمّي الآن تراباً بارداً، وأنتِ وحيدةٌ في غياهبِ اللَّحد؟ كيف تحتملين صمتَ القبر القاتل، وقد اعتدتِ على صخب الأطفال وأصواتهم العالية وضحكاتهم الرنانة؟ وتردَّدت في أرجاءِ روحي كلماتُ بدر شاكر السياب عندما تذكّر أمّه وهو غريبٌ وحيدٌ كسيحٌ طريحٌ في مستشفىً بِلندن:
البابُ ما قرعتُه غيرُ الريح في اللَّيلِ العميقْ،
البابُ ما قرعتْه كفُّكِ.
أين كفُّكِ والطريقْ
ناءٍ؟ بحارٌ بيننا، مُدُنٌ، صحارى من ظَلامْ
الريحُ تحمل لي صدى القُبُلاتِ منها كالحريقْ
من نخلةٍ يعدو إلى أُخرى ويزهو في الغمامْ
...
قال في نفسه لكي يخفِّف من مصابه إنَّها أدَّتْ رسالتها في الدُّنيا، وخلَّدتْ نفسها في أولادها الاثني عشر الذين وهبتهم الحياة وسهرت الليالي في سبيل تربيتهم وإسعادهم. ولكن ماذا يفيد الوردة بعد أن وتسقط تذبل من الغصن وتدوسها الأقدام، إذا كان الشعراء العِظام قد خلَّدوها في قصائدَ يتضوَّع منها أريجها كلّما أُنشِدت على مرِّ العصور؟
رحلتْ أُمّي ولكنَّ خطاها ما زالتْ على الدرب القديم، ولمسات أناملها على مقابض الأبواب العتيقة، والقلوب الخافقة بحبِّها؛ ورائحة الحناء المنبعثة من ذوائبها تسري في الممرّات تسابق النسيم، وتصل حاسَّة شمّي فتخدِّرني بالحنين. آه، يا أُمّي! العمر ينقضي، والآمال المحبطة والأحلام المجهضة تبقى غصَّةً في الحلق، وحريقاً بين حنايا الروح. كانت عيناكِ، يا أُمّي، قنديلَين في ظلام الغربة، أحفظ بهما توازن خطواتي المتعبة. كنتِ تزرعين البسمة في دربِ أحزاني، وأنا أواصل السير ظنّاً مني أنَّ الأرض مدورة وأنّي سأعود، إذا ما بقيت سائراً، إلى النقطة التي انطلقتُ منها، فألقاكِ يا أُمّي. كنتِ تحافظين على كياني موحَّداً متماسكاً، أمّا اليوم فإنَّ موتكِ يشتِّتُ روحي، ويبذر أشلاءها في حقول الحيرة، والأسى، والغربة.
أيواسي نفسه بترديدِ القول المأثور " الموت أهون مما بعده وأشدُّ مما قبله."؟ أيواسي نفسه بالقول إنَّ الموت بدايةُ حياةٍ جديدةٍ للروح، إذا استحال الجسد إلى تراب؟ إنّه تناقضٌ واضحٌ فاضحٌ؛ ولا بُدَّ من أنَّ هذا التناقض في معنى الموت ناتج عن الإبهام والغموض اللذَين يتَّصف بهما الموت نفسه، لأَنَّه نوعٌ من العدم، والعدم لا يفصح عن شيئ. أم أنَّنا لا نعرف مصيرنا، لأنَّنا لا نعرف بدايتنا، من أين أتينا؟ ولا نعرف غايتنا، إلى أين نحن ذاهبون؟ أيواسي نفسه بترديدِ كلامِ الفلاسفة أنَّ الموت فعلٌ عامٌّ وخاصٌّ، عامٌّ لأنّه يعمُّ جميع الناس، وخاصٌّ لأنٌّ كلَّ واحدٍ منهم يموت وحدَه. إنَّه فعلٌ ولكنَّه يقضي على كلِّ فعل، فما أسوأكَ، أيها الموت.
كان فراق أُمِّه وهي على قيدِ الحياة، بالنسبة إليه، نوعاً من الموت يمكن تسميته بالموت الأصغر. أمّا اليوم فإنَّ الموت الأكبر قد أقترب منه أو هو اقترب من الموت الأكبر، اقتراباً ظنَّ معه أَنَّه يستطيع أن يُحدِّد ماهيَّته بشكلٍ أدقَّ، وبصورةٍ أكثرَ جدّيَّة. ولكنَّ جدِّيته لا تنسجم مع عبثيَّة الموت، فالموت لا يكشف عن جوهره إلا لعابث مثله. كان عليه أن يتعامل مع الموت باحتقارٍ وإهمال، كما تعامل معه الشاعر الإنكليزي جون دون، الذي خاطب الموتَ باستعلاءٍ قائلاً له: "إنَّ النوم العادي يفعل ما تفعل ويعطي ما تعطي، فلا تفخر ولا تتبختر، وسيأتي يومٌ تموت فيه أنتَ، أيّها الموت!"
ستجابه مصيرك المحتوم، أيُّها الموت! كم أتمنى أَن أشهد ساعةَ هزيمتكَ الأخيرة، لحظاتِ موتكَ، أيُّها الموت! لا تتكبَّر، أيُّها الموت، ولا تجرّ أذيالك متباهياً متبختراً، وجميع من حولكَ يرتجف فَرَقاً منكَ، فهناك من الرجال الذين لا يخشونكَ ولا يرهبونك. ألم تسمع الإمام علي حين قال: " أتخوِّفونني بالموت، واللهِ لا آبهُ إن سقط الموتُ عليَّ أم سقطتُ عليه." وهنالك مَن قام بمطاردتكَ أيُّها الموت غير هيّابٍ، لأنَّه ظنّ أنَّ فيك شيئاً مثيراً جديداً يبدِّد ملل الحياة وسأمها، كما فعل نجيب محفوظ حين صرخ: " أين محطةُ الموت، فقد سئمتُ مركبةَ الحياة المملَّة." كيف ينبغي أن نتعامل معك، أيُّها الموت، يا ترى؟
في تلك الليلة، بين الحُلم واليقظة، بين الواقع والخيال، مرَّ أمام مقلتيه، في موكبٍ رهيب جميع أولئك الأحبّة الذين رحلوا عن دنياه، وبقيت وجوههم لصيقةً ببؤبؤ العين: أخوه أحمد الذي قدّم مهجته فداءً لفلسطين في جنين، سمع عن موته ولم يرَه رؤية العين، وإن ظلَّ يتخيَّل ساعة سقوط البطل في أشكال متعدِّدة وصور مختلفة؛ جاره صديق طفولته الصغير عبد العظيم الذي أصابه لهيبُ حريقٍ شبَّ في براميل الزيت في ساحة الدار فظلَّ ثلاثة أيام يتلوى ألماً حتّى فاضت روحه، وسليم الصغير يجلس مشدوهاً إلى جانب سرير الموت؛ زميله في المدرسة الابتدائية التلميذ الصغير حسين الذي غرق في النهر، وعندما عثروا عليه بعد يومَين أخرجوه وقد انتفختْ جثَّتُهُ وتضخَّمتْ؛ وجدّه الذي أسلم الروح على فراشه في غرفته المعهودة وهو باسم يتلو القرآن وقد أمسك بيديه أبناؤه في حين كانت النساء تذرف الدمع وتخنق النشيج والعويل حتى علا صوت الرجال مكبِّرين؛ وزميلته في الكلِّيَّة حبُّه الأوَّل، وداد، التي اختنقت بالغاز في حمام المنزل، وانتقلت روحها إلى بارئها، ولكنَّها ظلّت تعوده في أحلام النهار وكوابيس الليل؛ ورفيق غربته في بيروت زكي الذي أطلقوا عليه النار في شارع الحمراء فأردوه قتيلاً. كلُّ أولئك الأحبة مرّوا أمام عينَيه بسرعةٍ مذهلة.
ومَن لم يمُتْ بالسيفِ ماتَ بغيرهِ تعدَّدتِ الأسباب ُ والموتُ واحدُ
لا، أيُّها الموت، لستَ واحداً، فأنتَ تداهمنا متنكِّراً بأشكالٍ متعدِّدةٍ مثل ساحرةٍ لعينة. لا، أيُّها الموت، لستَ واحداً. تمنيتُ لو كنتَ واحداً تُدرك جميع الناس قدراً محتوماً في عمرٍ واحد، ووقتٍ واحد، وطريقةٍ رحيمة واحدة؛ ولكنَّك لا تنفكُّ تبرهن على قسوتك وشناعتك وجورك وخداعك..
هذه الافتراضات التي حيَّرت كثيرين قبله، استحوذتْ على فكره في تلك الليلة، سلبت من عينَيه النوم، حشت فراشه ظنوناً وشوكاً. أمّا الموت فقد ظلَّ على دأبه وسيره الحثيث، لا يخفِّف من غلوائه سؤال، ولا يفتُّ في قسوته بكاءٌ ولا رثاء.
***
في تلك الليلة داهمتني رغبةُ الكتابة مثل حصانٍ جامح. كنتُ أتساءَل أحياناً بيني وبين نفسي ما الذي يؤجِّج تلك الرغبة في الأعماق. ولماذا تجافيني أياماً وأسابيعَ وشهوراً وسنين؟ ما بواعثها وما أسرارها؟ سألتُ بعض الكُتّاب المُكثرين: متى تكتبون؟ وأين تكتبون؟ وكيف تكتبون؟ وأي وضع جسدي تتَّخذون عندما تكتبون؟ فلمْ أَجد اتِّفاقاً في إجاباتهم. قال بعضهم: لكي تكتب يجب أن تقرأ أدباً راقياً. فالأدب الحقيقيّ يمتاز بقدرته على إيقادِ جذوةِ الإبداع في نفس القارئ، والإتيان بأفكارٍ جديدة، وأساليبَ جديدة. وقلتُ في نفسي: ليس المهمُّ أن نرفض المألوف في سبيل التجديد، ولكنَّ الأهم أن نأتي بالبديل الأفضل، وإلا فالقديم الجيِّد خيرٌ من الجديد السيئ.
يلجأُ كثيرٌ من الكُتّاب إلى الخمرة والمخدِّرات لشحذِ التخيُّل وتحفيز الإبداع. وكان الشاعر الرومانسي شارل بودلير صاحب كتاب " الجنة الاصطناعيَّة " ينصح الأدباء بتناول جرعاتٍ إضافيةٍ من الخمرة والشعر والفضيلة. فالخمر يحرِّرُ العقل من عقاله، ويخلِّص الحياءَ من وثاقة. وكان أبو محجن الثقفي وأبو نواس يكرعان الخمر وينظمان الشعر. أمّا همنغواي وجيمس جويس وسكوت فيتزجيرالد، فكانوا ينتبذون زوايا قصية في مقاهي باريس في سنوات الجنون أوائل القرن العشرين، ويتناولون أنواعَ الخمرةِ للوصول إلى حالة الانتشاء التي تهَب أفكارَهم أجنحةً تُحلِّق في عالمِ الخيال والإبداع. أمّا سليم فيردد مقولةَ " إنَّ الله خلقَ الماء، وخلقَ الإنسانُ الخمر"، ولهذا لا يعاقر الخمرة ولا تعاقره، ولا يحبّ المقاهي ولا تحبُّه. لا يدري إن كانت تطربه لو التجأ إليها، بَيدَ أنَّه يدرك أنَّ الحزن والوحدة يطربانه، يفجِّران وجدانه، ويضرمان رغبةَ الكتابة في أعماقه. للحزن تأثيرُ الخمرِ ومفعوله، والوحدة تهبه جزيرةً نائيةً عن بقية الجزر، محاطةً بأسماكِ القرش الشرسة، ولا يقربها سابح أو متنزِّه. وهذه الليلة طافحةٌ بلونِ الحزن، عبقةٌ بأريجِ الوحدة. فليقطع الليل بالكتابة، فالكتابةُ خيرٌ من النوم.
لاحظتُ أنَّني أكتب عندما تغطس روحي في خلجانِ الأسى، وأتيه غارقاً في أرخبيلِ الأحزان. عند ذاك تتلوى الأبجديَّة، وترقص مذبوحةً طافيةً على سطح الحزن الآسن، وتتدفَّق الكتابة مثل ينبوع دم. وكما تنساب القطرات إلى القطرات، وكما تنهمر الدموع على الدموع، تتداعى الكلمات إلى الكلمات، وتتوالى الصور، فتتشكَّل الكتابة حرفاً حرفاً وعبارةً تلو أُخرى، ويتحوَّل المُتخيَّل إلى المرئي، وحواسي بين شدٍّ وجذبٍ وربطٍ وإيلامٍ بين أمواج مشاعري المتلاطمة.
أكتب بحثاً عن الزمن الضائع. أطارده في كهوف الذاكرة، كمن يطارد فراشات ملوّنة في حقولٍ مزدانةٍ بالخضرة والربيع. أطارد الزمن الضائع، لأقبض عليه وأعتقله في سراديب الزمن الحاضر، ليتَّسع المستقبل لي قليلاً. أواجه الموتَ بالكتابة، فأنا شهرزاد التي تحكي لتحيا، وتسرد من خيالها ما قد يؤجِّل الموت ويُبطئ الزمن. أنا الكاتب الساحر الذي يحوّل حجارة الحاضر إلى ذهب الماضي لينعم بالمستقبل. أخشى رحمَ الأرض الفاغر فمه في ثنايا المستقبل. أخشى رحم الأرض، أتجنبه، أبتعد عنه، أعود إلى رحم أُمِّي لأولد من جديد. أعود بالكتابة إلى الزمن الماضي، زمنِ البدايات والأساطير، لأبتعد عن زمن النهاية الذي تحكمه الآلة.
الحزن هو العاطفة التي تفجِّر رغبتي في الكتابة. لعلَّ الحزن أقوى من الفرح إن لم يكُن أعتى العواطف الإنسانيَّة جميعها، فلحظةُ حزنٍ واحدةٌ تمسح ساعاتٍ طويلةً من الفرح كأنَّها لم تكُن أبداً، وتفجِّر في خبايا الروح ينابيعَ الأحاسيس والمشاعر والعواطف. وللفرح أغنيةٌ أُخرى لم يتيسَّر لي سماعها، ولم أتهجَّ أبجديتها، ولا أجيد توقيعها، ولا أداءَها. أمّا الحزن فهو مقيمٌ في شمال الروح وجنوبها، ومستقرٌّ في سويداء القلب وصميمه، منذ عصورٍ سحيقة، حتّى أدمنتُ عليه، منذ عصورٍ لم يعُد عقلي قادراً على حسابها، أو تذكُّر أحداثها، ربّما منذ أن تركتني حبيبتي أركب سفينةَ نوح ولم تلحق بي، وظلّتْ واقفةً على التلّ دون أن تكترث لندائي لها أن تركب السفينة معنا، ودون أن تأبه بصراخي. ربَّما منذ أن غدرتْ عشتار بالراعي ديموزي وقادته إلى العالم السفليِّ، وأوغرتْ صدور الزبانية عليه، وغادرتِ المكان، وتركته هناك، بعد أن جعلتهم يُوصدون الأبواب في وجهه، ويُمعنون في جلده بالسياط، وحرقِ أجزاء جسمه الحساسة بالنار، وسملِ عينَيه، وقطعِ لسانه، وبترِ أطرافه.
***
في تلك الليلة، كتبَ سليم في دفترِ مُذكَّراته:
"رحلتْ أُمّي وما زالتْ لمساتُ أناملها على مقابضِ الأبواب وأوتارِ قلوب أطفالها. رحلت أُمّي وبقيت رائحةُ الحناء والياسمين تعطّر النسيم على الستائر المرتعشة، وتسري على أثارِ أقدامها في ممرّات منزلنا العتيق. رحلتْ أُمّي وما زالت خطوتها لم تتعدَّ عتبة الباب لتبلغ الدرب العريض. دُفِنت ودُفِنت معها جميع أحلامها وآمالها وآلامها. عجباً لك أيُّها اللحد الضيق، كيف استطعتَ أن تأوي كلَّ تلك الأحاسيس الواسعة والآمال العريضة؟
كانت أُمّي نقطةَ الضوء البعيدة التي توازن خطواتي في طريق العودة المظلم إلى وطني، يا إلهي. كانت أُمّي تشكّل اللازمة في سُلَّم روحي الموسيقي، وإذا اختفتْ اضطرب اللحن، واختلَّ النغم، وأصابني الدوار والضياع. في أزماتي، كانت أُمّي أريجَ الخزامى يهدئني وينعشني في الوقت ذاته، والآن تذبل زهور الخزامى ويتلاشى عطرها.
عندما ودَّعتكِ، يا أُمّي، تلك الليلة المشؤومة، قلتُ لك: سأرحل بعيداً بعيداً عنكِ، قلتِ لي وأنتِ مدركة عمق المأساة: لا، انتَ قريب جدّاً منّي ما حييتُ، فإنَّكَ مهما بعدتَ، فأنتَ في قلبي دوماً. سأتحدّث إليك كلَّما أشرقت الشمس وكلَّما غربت، قد لا أسمع جوابك، ولكنِّي أدرك ما تقول لي وأحسّه بنبض القلب.
كلّما تذكرتك يا أُمّي أينع جرح في الفؤاد، وكلّما تعوّذتُ باسمكِ، ظلَّ طعم الدمع على شفتيّ. كنتِ تذرفين الدمع السخين سخياً من أجل الفقراء والغرباء والبائسين والمظلومين، قريبين منك كانوا أم بعيدين، فما أرقّ قلبكِ، يا أُمّي. أفلا تستحقين دمعةً مني يوم رحيلك الأخير؟
قومي، يا أُمّي، من مرقدكِ، ولو للحظةٍ واحدةٍ، وامسحي دمعتي من عيني، كما كنتِ تفعلين في طفولتي. انهضي، أيّتها الحبيبة، من ضريحك، ولو لدقائق معدودات، وحنّي وجنتَيَّ كما كنتَ تفعلين في صغري، ولكن، حنِّيهما هذه المرَّة بقُبلةِ وداعٍ تخفِّف من شجنِ الفراق الأبديِّ.
ذاكرتي موشومةٌ بدموعكِ يا أُمّي. تمنيتُ أنْ أموت في يومٍ هادئٍ على الفراش الذي ولدتُ فيه في حجرتكِ التي تظلِّلها نخلتنا الباسقة. تمنيتُ أنْ أموت بين ذراعَيك فتذرفين دموع الفراق، تماماً كما ضممتني إلى صدركِ يوم ولِدتُ وذرفتِ دموع الفرح. أمّا اليوم وقد رحلتِ، فمَن الذي سيبكيني، يا أُمّاه؟
تذكَّر سليم أنّه عاد ذات يومٍ من مدرسته الابتدائية، وكانت سنته الأولى في تلك المدرسة. رأى أُمَّه جالسةً واجمةً وحيدةً في باحة الدار، والدمع يتحدّر من عينَيها بصمتٍ وبلا نحيب. ظنّها تبكي أخاه أحمد الذي استشهد في فلسطين. فقال لها:
ـــ ألم تقولي لي يا أُمّاه نحن لا نبكي الشهيد، فهو لا يموت وإنّما يبقى خالداُ في الجنَّة.
ــ نعم، نحن نزف إليه التهاني لا الدموع. أعمامك الهواشم قاتلوا الغزاة في الخليج أزيد من مائتي عام، وسقط منهم العشرات والمئات ولم تذرف امرأةٌ هاشميَّةٌ ثكلى أو أرملةٌ دمعةً واحدة. كانت نساؤهم يزغردن عندما يسقط منهم شهيد، ورجالهم يكبِّرون.
ـــ ولكنَّ العراقيِّين يبكون الأمام الحسين في محرَّم الحرام من كلِّ عام منذ أن قُتل على أرضهم قبل أكثر من ألف عام، يا أماه. أليس الأمام الحسين شهيداً؟ فكيف تفسِّرين ذلك؟
ـ بلى، إنّه سيِّد الشهداء، ولكنَّنا لا نبكي الحسين الشهيد، يا ولدي. نحن نبكي غربة الحسين. نبكي غربة السبايا من آل رسول الله.
اليوم أفْهمك يا أُمّي. فالغربة تستحقُّ أكثر من دموع العين. الغربة تستحقُّ أن تُنزَف لها دماءُ القلب حتّى آخر قطرة.
ــ إذاً لماذا تبكين يا أُمّي اليوم، إذا لم تكُن دموعك من أجل أخي أحمد الذي استشهد في فلسطين؟
ـــ أبكي الفلسطينيِّين الذين شُرِّدوا من ديارهم ظلماً. قتلوا شيوخهم وأطفالهم، اغتصبوا أراضيهم وأملاكهم، أحرقوا زرعهم وضرعهم، هدَّموا دورهم على رؤوسهم، صادروا مواشيهم، طردوهم من بيوتهم. هجَّروهم وجعلوا منهم لاجئين في ديار الغربة.
ـــ لا تبكي، يا أُمّي، سيعود الفلسطينيّون إلى أرضهم. الظلم لا يدوم.
كفكفتِ دموعك، وجاهدتْ بسمةٌ للوصول إلى شفتَيكِ، وأنتِ تضمِّينني إلى صدرك الحنون.
وتفهَّمتُ بكاءَك على اللاجئين، والشهداء، والمجاهدين الفلسطينيِّين، فقد جاهد أبوك في ثورة العشرين وجُرِح جرحاً بليغاً، ونجا من الموت بأُعجوبة، وظلَّ طوال حياته يعانق رصاصةً بين الضلوع وفخراً خفيّاً في بريق عينَيه.
لم توقفي دموعكِ يا أُمّي على الفلسطينيّين فقط، وإنَما أرسلتِه مدراراً في مناسباتٍ كثيرةٍ، من أجل جميع البائسين والمنكوبين. أذكر يا أُمّي أنّني بعد سنواتٍ قليلةٍ، عدتُ من مدرستي الابتدائيّة، ودخلتُ منزلنا. فاجأتُك جالسةً على الأرض، وأنتِ تندبين وتنتحبين وحيدة. فرحتِ تكفكفين دمعكِ بأطرافِ عصابة رأسك، وترسمين بسمة مُقحمَة على شفتَيك، مرحِّبةً بعودتي. وسألتكِ:
ـــ ما الذي حدث، يا أُمّي؟ لماذا تبكين؟
قلتِ وقد عاد الحزن إلى صوتكِ المخنوق بعَبراتكِ:
ـــ هزّة أرضية في أغادير. مات جميع أهل المدينة المساكين. مصيبةٌ حلّت بالمسلمين.
ـــ لا حول ولا قوَّة إلا بالله.
كنتُ جائعاً ذلك اليوم عندما عدتُ من المدرسة، ولم أرَ طعام الغداء مُعدّاً كما هي العادة. فأنتِ لم تعجني ولم تخبزي ولم تعدّي الرُّزَّ والمرق. فالحزن عندنا يلغي الأكل والتزيين وكلَّ شيءٍ آخر. ولحظتِ الجوع في عينيَّ، وقلتِ لي:
ـــ انتظر، يا حبيبي، سأسلق لك بيضتَين.
ونهضتِ إلى المطبخ. ولم أستطِع الانتظار، فدلفتُ خارجاً من المنزل إلى دار خالتي المجاورة لأشارك ابنها محمّد طعامه، فقد عدنا سويّةً من المدرسة قبل دقائق.
وقال لي محمد على استحياء:
ـ أُمّي هي الأخرى كانت تبكي على ضحايا أغادير، ولم تطهِ شيئاً.
وناولني حفنةً من التمر التهمتُها.
في تلك اللحظة، شعر سليم أنَّ الكهرباء التي دخلت قريتهم، لم تجلب الضوء والمذياع فحسب، وإنَّما كذلك الأخبار المحزنة التي جعلت أُمّه وغيرها من النساء، يبكين يوماً بعد آخر على مصائب الآخرين أينما كانوا.
الحزن، يا أُمّي، قَدرنا، نحن العراقيّين، منذ أيام السومريّين عندما غدرت عشتار بالراعي العراقيِّ المسكين ديموزي، أعني تموز. وجميع أشعار السومريِّين كانت مطبوعة بالحزن، نديَّة بالدمع، مجلَّلة بالسواد، مسربلة بالكآبة. نحن الذين اخترعنا المرثيات والبكائيات والمناحات قبل أن تنشدها الخنساء أو يرددها متمم بن نويرة. أما يكفينا بكاءً يا أماه؟!
كان قلبه يفيض أسىً
فهام على وجهه في المروج
الراعي ديموزي ـ كان قلبه يفيض أسى
ومزماره يتدلى من رقبته وهو يبكي
...
.
وبعد كلِّ الدموع التي ذرفتْها عيناك في حياتكِ، ألا تستحقّين دمعةً من عيني في مماتكِ؟!
وتذكَّر سليم أنَّ أُمَّه ليست الوحيدة من العراقيات اللواتي يذرفن الدمع عندما تحلُّ كارثةً بعربٍ أو مسلمين مهما كانوا بعيدين عنهن. فطَرأتْ على بالِهِ قصيدة " الكوليرا " للشاعرة نازك الملائكة. أرادت الشاعرة أن تُعبِّر في تلك القصيدة عن الحزن والألم اللَّذَين أَلمّا بها لدى سماعها انتشار وباء الكوليرا في مصر، مصر معقل العروبة وقلبها النابض. لا بدَّ أنَّ الشاعرة نظمتْ قصيدتها مع النشيج والنحيب المتقطِّع المنبعث من أعماق روحها، وبكتْ وناحتْ كما كانت أُمُّها تبكي وتنوح على الأمام الحسين في مجالس العزاء العاشوريّة التي تُقام في العشر الأوائل من كلِّ شهر محرم الحرام. ولكنَّ أوزان الشعر العربيّ كلَّها لم تستوعب حزنَ الشاعرة، ودموعها المتساقطة المتلاحقة بسرعة، ونشيجها المتقطِّع المتوجِّع، فجاءتْ قصيدتها على صورة تفعيلات شكّلت فيما بعد حجراً أساساً في صرح حركة الشعر الحرّ:
سكَن الليلُ
أَصغِ إلى وَقْع صَدى الأنَّاتْ
في عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأمواتْ
....
وتذكَّر سليم القصائد التي كتبتْها نازك الملائكة وعشرات الشعراء العراقيِّين ومنهم صديقُ طفولته الذي اختطفه الموت في عزّ شبابه، حميد فرج الله، عن الثورة الجزائريّة وشهدائها الذين سقطوا واحداً تلو الآخر وهم يحتضنون راية الجزائر قريباً من مهجهم. وتذكَّر عمله في وكالة الأنباء العراقية في حي الصالحية في بغداد أثناء دراسته في كلِّيَّة التربية ببغداد أيام اندلاع الثورة الجزائريّة. فقد احتاجت الوكالة إلى عددٍ من المترجمين والمحرِّرين، لإعداد النشرات الإخباريّة التي كانت تبعث بها إلى إذاعة بغداد في حي الصالحية كذلك على بعد شارعَين أو ثلاثة من الوكالة، فأجرت اختباراً لعددٍ من المرشَّحين وكان هو من الفائزين.
كان رئيس قسم الأخبار في وكالةِ الأنباء العراقيَّة آنذاك رجلاً صارماً يُسمّى الأستاذ صباح عبد المسيح، وأعطى تعليماته لجميع المسؤولين عن إعداد نشرات الأخبار بأن لا تخلو نشرةٌ إخباريّةٌ من أنباءِ بطولاتِ الثوار الجزائريّين، لتبقى الثورة حيّة مستعرة في قلوب المستمعين العراقيِّين وضمائرهم. وذات يوم عرض سليم نشرة الأخبار التي أعدها، على الأستاذ عبد المسيح للحصول على تأشيرته قبل إرسالها إلى دار الإذاعة، فألقى عليها الرئيس نظرةً وقال بنبرةٍ فيها شيءٌ من اللوم:
ــ لا يوجد أيُّ خبرٍ عن الثورة الجزائريّة في هذه النشرة؟!
فقال سليم معتذراً:
ــ لم يصلني أيُّ خبر عن الجزائر بـ "التلبرنتر" من وكالات الأنباء، ولا من قسم الإنصات على الإذاعات هذا اليوم.
ــ لا يهمّ.
قال الرئيس عبد المسيح ذلك ورفع عصاً طويلةً كانت إلى جانبه، ووضع نهايتها بحركة اعتباطيَّة على خريطة الجزائر المُكبَّرة المعلَّقة على جدار المكتب خلفه، وسأل:
ـ أيّة بلدة وقعتْ عليها العصا.
أجاب سليم بجديّة:
ـ باتنة،
قال له الرئيس:
ـ الآن اكتب: " شنَّ أبطالُ جبهة التحرير الجزائريّة هجوماً بالقنابل اليدويّة والأسلحة الأوتوماتيكيّة على حاميةٍ عسكريَّةٍ فرنسيَّةٍ في منطقة باتنة في جبال الأوراس الشماء، وأوقعوا خسائرَ جسيمةً في صفوف الجنود الفرنسيّين ومعدّاتهم، وقد استُشهد في هذه العمليّة عدد من الثوار الأشاوس. ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون.﴾ "
انتهى سليم من الكتابة وعلى شفتيه ظِلُّ ابتسامةٍ باهتةٍ، ورفع رأسه وهو ينظر إلى رئيسه باندهاش، وقال بعد شيءٍ من التردُّد:
ـــ ألم تقُل لنا أثناء التدريب إنَّنا ينبغي أن ننقل الخبر بأمانة ولا نخلقه ولا نغيّره ولا نعلّق عليه، لأنّنا صحفيّون ولسنا روائيّين نستلهم الخيال، ولا محلِّلين ولا معلِّقين سياسيّين نبدي وجهة نظرنا؟!
كان جوابُ الرئيس بلهجةٍ آمرة قاطعة توحي بإنهاء النقاش في هذا الموضوع:
ــ ولكنَّها، الجزائر، يا ولدي.
كانت دهشة سليم مضاعفة لاستشهاد رئيسه بآيةٍ قرآنيَّةٍ في خبر ملفَّق، ولم يدرك أنَّ الرجل مسيحيٌّ ديناً وعقيدةً، ومسلمٌ ثقافةً ووطناً، كما قال الزعيم المصري مَكْرم عبيد عن نفسه ذات يوم.
***
في اليوم التالي، لم يعرف سليم ما الذي ينبغي أن يفعل للتنفيس عن حزنه، والتخفيف من آلامه الدفينة. هل يبقى في شقَّته يكفِّنه السكون، وليس في مقدوره أن يفعل شيئاً سوى أن يدثِّر الأسى بالصبر، ويواري الغربة بالصمت، أم يسير حتّى آخر الشارع حيث يجري نهر كولارادو فيبثّه ما به من شجى، وهمٍّ، وغمٍّ، وحنين؟ وأخيرا صلّى ركعتَين ترحُّماً على روح أُمِّه، وذرف دمعتَين بصمت، وذهب إلى الجامعة في الصباح والمشتل بعد الظهر، فالعمل عبادة.
سرتُ ذاهلاً في أزقة المدينة. رأيتُ الحزنَ مخيماً على البنايات والنوافذ والأشياء والأشجار، وحتّى على الأزهار في قارعة الطريق وفي المشتل. رأيتُ الحزن في قلبي وعلى عيني.*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- فصلة من رواية :
علي القاسمي. مرافئ الحب السبعة، ط1 (بيروت/الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012).
بمناسبة صدور ترجمتها الفرنسية عن دار لارمتان في باريس بتاريخ 22/12/2021.
وللرواية عدّة طبعات، وهي متوافرة مجانا للقراءة والتحميل في موقع (أصدقاء الدكتور علي القاسمي) على الشابكة.
تقييم النص
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا
التعليقات
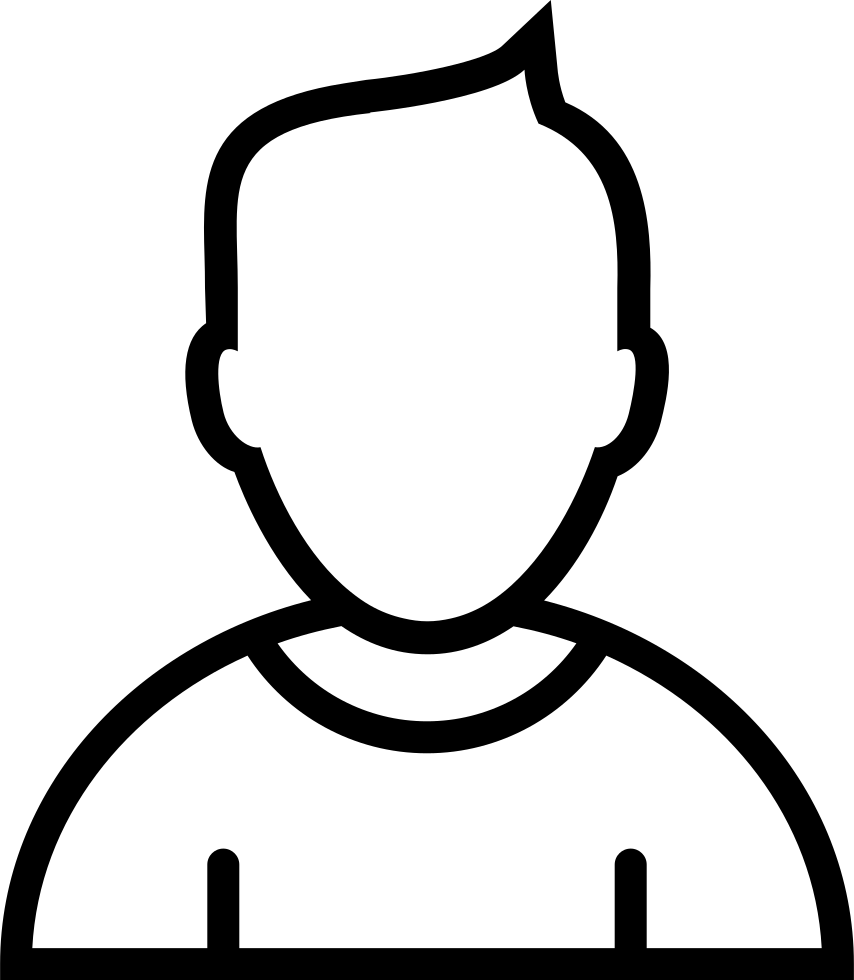
جمعة عبدالله
10-03-2022 03:07
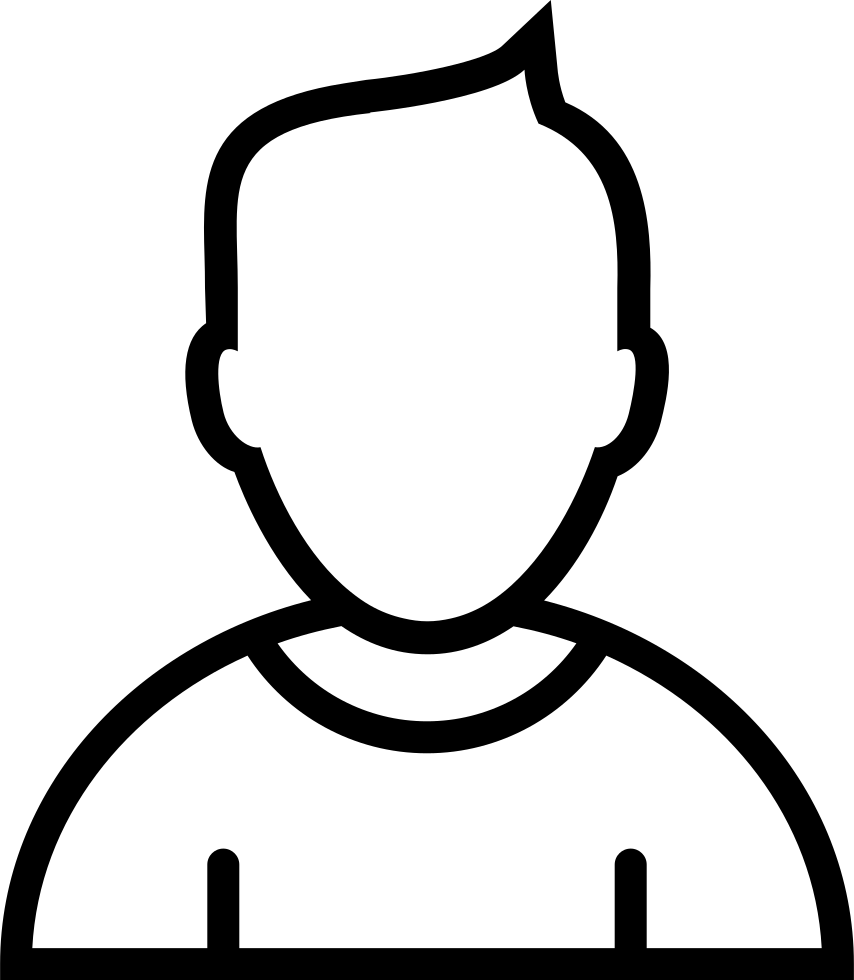
علي القاسمي
10-03-2022 03:10
أخي العزيز المفكر الأديب الأستاذ جمعة عبد الله حفظه الله ورعاه،
شكراً جزيلاً على تعليقك المذهل، الذي ينم عن استبطانك للنص الأدبي وتماهيك فيه ومعه، فيأتي تحليلك أصيلاً دقيقاً صادقاً.
عندما كتبتُ هذا النص كان في ذهني بكاء نساء البلدة ، في طفولتي في الخمسينيات من القرن الماضي، على نكبة الفلسطينيين، وعلى ضحايا الكوليرا في مصر، والمغاربة الذين قتلوا في زلزال أكادير. وبعبارة أخرى شعور نبيل بالتضامن مع العرب المسلمين في كل مكان، أما اليوم فلا نجد هذا التضامن، بل حل محله نوع من التنافس والتنازع، وأحياناً الكره والحقد!!!
تمنياتي لك بالصحة التامة والإبداع المتواصل.
محبكم: علي القاسمي





لا يوجد اقتباسات